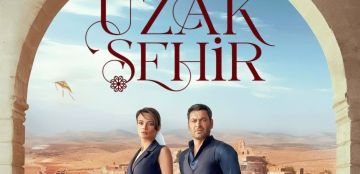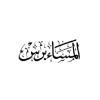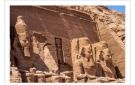اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥
حسام الدين محمد*
يقدّم الكاتب الفلسطيني السوري ساري حنفي مبحثا شديد الأهمية، بمحاولته الإجابة على الأسئلة المركزية للعالم، عبر جمعه بين المعارف الواسعة للباحث الأكاديمي، وحرارة المثقف العضويّ المنهمك في الشأن العام. على هدي هاتين الصاريتين تتحرّك بوصلة الكتاب بقوة، ولكن بتؤدة، فيبدو العنوان الرئيسي، «ضد الليبرالية الرمزية»، تعبيرا جليا عن حيوية الناشط في قضايا الاجتماع والثقافة والسياسة، فيما يعبّر عنوانه الفرعي «دعوة إلى علم اجتماع تحاوري»، عن خبرات المحاضر الجامعي ومعارفه الأكاديمية الواسعة.. وهدف الكتاب.
مصداق ذلك أن حنفي لم يعد إلى المكتبات فحسب، فكتابه «يمثل عصارة سنوات من العمل الميداني المكثّف، أجريت خلالها كثيرا من المقابلات، وتواصلت مع علماء اجتماع في أنحاء شتى من العالم»، وأن الكتاب «يجمع بين التأملات والإحصاءات والمقالات الإثنوغرافية». يقدّم الكاتب بذلك معادلة بديعة توازن بين الشخصيّ والعام، والواقع والنظرية، وسجال غرف الدراسة مع مخيمات الطلاب المناضلين، فيخفف سرد الحوادث الشخصية ثقل الظواهر الفكرية المعقّدة ويفسّرها بجلاء.
لا يمكن للأنثروبولوجي أن يصوم
من ذلك مثلا ابتداء الكاتب فصلا عنوانه «العلمانية دينا والعلمانية المتعددة الثقافات»، بحكاية لصديق له تونسي كان يقدم أطروحة ماجستير في الأنثروبولوجيا، حيث دعته المشرفة على أطروحته للقدوم إلى بيتها لنقاشها «على غداء خفيف»، وحين اعتذر لأنه صائم، انفجرت في وجهه قائلة: «لا يمكنك أن تكون أنثروبولوجيا وأنت ملتزم بالصيام (أي متدين) ثم أنهت المكالمة. يعلّق حنفي على الحادثة بالقول إن «كثيرا من أكاديميي فرنسا يعتبرون أن العلمانية تتطلب نظرة عدوانية تجاه الدين»، ويشرح بعد ذلك الكثير من المفاهيم الشائكة.
يمكن تتبّع تنويعات هذا الأسلوب في الكتاب باستعارة فكرة «النقد المزدوج»، عنوان كتاب عبد الكبير الخطيبي المعروف، فكثيرا ما يُتبع حنفي ذكره لحدث، أو استشهاد بممارسة غربية ينتقدها، بحدث، أو استشهاد ينتقد ممارسة لعرب، أو مسلمين، أو من أرشيف فكر أو تاريخ الجنوب العالمي.
أحد أمثلة ذلك تعليقه على توجيه أستاذة القانون في جامعة بنسلفانيا كلير فينكلستين دعوة لتقييد حرية التعبير في ما يتعلق بفلسطين بالقول، إنها لم تكن ترى النقاش سوى من منظور «العنف والإحساس بالأمان»، ضمن حرم الجامعات الأمريكية، أما العنف الفعلي، مثل الإبادة الجماعية (في غزة) فلم تره؛ ثم إتباعه ذلك بتوجيه التعليق نفسه إلى عرب يؤيدون الفلسطينيين ويتأثرون بمقتلتهم الجماعية، ولكنهم يدعمون، في الوقت نفسه، القتل الجماعي الذي كان يمارسه نظام بشار الأسد السوري السابق بحق شعبه. تتعدّد أبواب هذا «النقد المزدوج»، فيذكر مثلا اقتراح أحد أساتذة الاجتماع العرب استبدال دراسة إميل دوركهايم، الذي صمت تماما عن الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بتدريس عالم الاجتماع الأمريكي الأسود دو بويز، فيقول: «ما العمل حين نجد أن دو بويز تجاهل مأساة الشعب الفلسطيني وأشاد بقيام دولة إسرائيل؟». ضمن حركته الجدلية هذه يحفل الكتاب بانتباهات فذة، تكشف التقاطع الكثيف لفضائي المعرفة المكثّفة لتعقيد الواقع، والنضال لتغييره (ما يذكّر طبعا بمقولة ماركس القديمة عن تغيير العالم لا تفسيره فحسب). من ذلك قوله واستنتاجه أن «الحرب على غزة تمثل انقلابا عميقا في النموذج المعرفي السائد، ليس على مستوى الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، بل على مستوى الديمقراطية الليبرالية الغربية في العالم، وأزمة العلاقة بين الشمال والجنوب، وكذلك على مستوى مشكلات الشعبوية والإسلاموفوبيا، فهي تكشف التوترات والاستقطابات بشأن استعمار فلسطين. كما تظهر دور مراكز القوى النيوليبرالية المختلفة»، ليتبع ذلك بالقول إن «المجموعات التي خرجت الى الشوارع دعما لوقف إطلاق النار (في غزة)، هي نفسها التي تدافع عن الأقليات المضطهدة وحقوقها، وهي نفسها التي تدافع عن البيئة».
الليبرالي الرمزي في داخلنا
يعطي كتاب حنفي فكرة الحوار موقعا مركزيا في مشروعه، وهو يحفز، فعلا، على الدخول في حوارات معه، أول هذه الحوارات يمكن أن يدور حول مصطلح الليبرالية الرمزية نفسه، وثانيها حول إمكانيات الحوار نفسه، وقدرته على تفكيك آليات الاستقطاب الهائلة، وصولا إلى دوره الممكن في مواجهة الإبادة.
أفترض أن السجال يجب أن يبدأ حول اعتماد حنفي مفهوم الرمزية للتعبير عن الاختلال بين المبادئ والممارسة. الليبراليون الرمزيون، كما يقول مايكل بوراووي في تقديمه للكتاب، «يُشهرون مبادئ لا يلتزمون بها». إنهم، حسب حنفي: «ليبراليون كلاسيكيا، لكن غير ليبراليين سياسيا». يستخدم هؤلاء رمز الليبرالية لا معانيها العميقة (في العدل والخير العامّين، إلخ)، ويبدو المصطلح صالحا للتعميم، حيث يطبّق على الاشتراكيين الرمزيين «الذين قوّضوا الوعد الاشتراكي»، والإسلاميين والرأسماليين.. وحتى للحديث عن «صهيونية رمزية». يرى حنفي أن المصطلح «نموذج تجريدي»، وأنه «قد يحمل كل واحد منا بعضا من ملامح هذا الليبرالي الرمزي»، لكنه ظاهرة تطاول جميع قطاعات الحياة العامة، بما يشمل الإعلام والسياسة والقانون والتعليم، ولا تقتصر على دول الشمال الكوني، بل تمتد إلى الجنوب أيضا.
أحد السجالات الممكنة مع أطروحات حنفي حول علم الاجتماع التحاوري، خصوصا غبّ استعانته بأطروحات ميشال فوكو حول السلطة والمعرفة، تتمثل بسؤال: وماذا نفعل حين تواجه هذه الاقتراحات توازنات الصراع والاستقطاب السياسيّ الذي تتحكّم فيه «حيتان المال والإعلام»، كما يقول، وحيث تستعمر الليبرالية الرمزية المجال العام، في «صراع اجتماعي شديد يقود إلى إقصاء فئات رئيسية في المجتمع»، حيث «يصبح كثير من الأكاديميين والفنانين والصحافيين خائفين على رزقهم، إذا حادوا عن الإجماع الظاهر المتفق عليه في أماكن عملهم، أو حتى إذا لم يبدوا الحماسة الكافية للخطاب المهيمن»، وحيث معايير التسامح نفسها، كما يقول، «تعزز سطوة الأقوياء»؟
حين يكون الخطاب مسموما
وحيث يستخدم الليبراليون الرمزيون الحقوق كأسلحة، ويحوّلونها إلى استراتيجيات تلويح وتمويه، مصممة لإخفاء الدوافع والمصالح الحقيقية لأصحابها، استراتيجيات تزيد من تهميش الأقليات الدينية أو العرقية (مثل تصوير مشروع التحرر الوطني الفلسطيني على أنه معاداة للسامية)، وتحرم الفئات المستضعفة من الخدمات الاجتماعية (مثل إقصاء الطالبات المحجبات من المدارس الحكومية في فرنسا ومقاطعة كيبيك الكندية). يجيب الكتاب بطرق عديدة على هذه الأسئلة، وعلى طريقته في اختيار الأمثلة الواقعية، يورد الكاتب مثال مقالة مشتركة كتبتها أماني جمال وكيرين يارهي ميلو، وهما عميدتان فلسطينية وإسرائيلية في الجامعات الأمريكية، معتبرا أنه «في هذه اللحظة الحساسة من تاريخ فلسطين/ إسرائيل تستطيع الجامعات جعل النقاش معقولا حين يكون الخطاب مسموما، مذكرة أن حرية التعبير لا تعمل إلا عندما يكون هناك خطاب سجالي قوي».
يقترح حنفي جوابا آخر بقوله إن علم الاجتماع المسلح بالخيال السوسيولوجي يعلمنا الطبيعة المعقدة للظواهر الاجتماعية، وأهمية مشيئة الفاعلين، ومنطق التهادي والتواد بين البشر. لا تأتي القوة دوما من التسلط والتسلسل الهرمي، أي من خلال آليات الهيمنة والمنافسة، لكن أيضا من التعاون والوفرة والرعاية.
*كاتب من أسرة «القدس العربي»