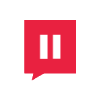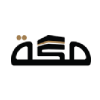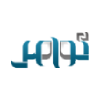اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦
د. عبدالعزيز اليوسف
المجتمع الذي يحمي كباره، ويوقّر آباءه وأمهاته، ويصون معلميه، هو مجتمعٌ يحمي نفسه من السقوط في ابتذال الشهرة. وفي النهاية، ما يبقى ليس عدد المتابعين، بل نوع الأثر..
في زمنٍ أصبحت فيه الكاميرا أقرب إلى الضمير، وأخفّ من مسؤولية الكلمة، برز نمطٌ مقلق من “السخرية الرقمية” التي لا تبحث عن نقدٍ واعٍ ولا عن إصلاحٍ اجتماعي، بل عن لقطةٍ مبتورة، ومشهدٍ منتقى بعناية، يُنزَع من سياقه ليُقدَّم مادةً للضحك السريع، والانتشار السهل، والتكسب البغيض. هنا لا تكون السخرية فنًا، بل استثمارًا في هشاشة المعنى، ولا يكون المحتوى رسالة، بل سلعة تُباع على حساب الكرامة.
السخرية، حين تفقد أخلاقها، تتحول إلى مرآة مشروخة تعكس المجتمع بزاوية واحدة، وتُقصي بقية الصورة. مؤثرٌ يلتقط تصرفًا عفويًا لكبير سن، أو كلمة مرتجلة لأب، أو انفعال أم، أو موقفًا تعليميًا لمعلّم، ثم يُعيد تدويره في قالبٍ تهكمي، كأن تلك الفئة اختُزلت في لحظة ضعف، أو جُرِّدت من تاريخها، أو أُلغيت إنسانيتها لصالح ضحكة عابرة. وهنا يصبح السؤال أخلاقيًا قبل أن يكون إعلاميًا: ما الذي نربحه حين نخسر احترامنا لأنفسنا؟
تقول الحكمة: “الرجل العظيم: قاسٍ على نفسه، والرجل التافه: قاسٍ على الآخرين”. وهذه العبارة تختصر جوهر الأزمة؛ فالمؤثر الذي يسخر من غيره إنما يتهرب من مساءلة ذاته، ويستبدل نقد النفس بتشويه الآخر. هو لا يرى في المجتمع إلا مادة خامًا للاستهلاك، ولا يقيس أثر كلمته إلا بعدد المشاهدات، متناسيًا أن التأثير الحقيقي لا يُقاس بالانتشار وحده، بل بالأثر الباقي في الوعي.
ولأن الإنسان كائن أخلاقي قبل أن يكون رقميًا، فإن التمييز بين الخير والشر لا يحتاج إلى مؤشرات تفاعل، بل إلى قلبٍ يقظ. “على الإنسان أن يميّز بين الخير والشر بنفسه، مستلهمًا حكم قلبه”. غير أن بعض المحتوى يربك هذا الميزان، ويجعل السخرية معيارًا، والاستخفاف فضيلة، والانتقاص طريقًا للشهرة. وهنا تتحول المنصات من فضاءات تواصل إلى مسارح استهزاء، يُصفَّق فيها لمن يجرؤ على كسر الهيبة، لا لمن يحفظ الكرامة.
النية، في هذا السياق، ليست تفصيلًا ثانويًا، “الحقيقي ينجو دائمًا بطريقته ما؛ النيات الصادقة تصل مهما كانت بطيئة”. فالمحتوى الصادق قد لا يلمع سريعًا، لكنه يبقى، بينما المحتوى المتكسب بالسخرية قد يحقق قفزات رقمية، لكنه يترك فراغًا أخلاقيًا يتسع مع الزمن. وما أسرع ما ينقلب هذا الفراغ على صاحبه؛ فالجمهور الذي يضحك اليوم قد يُسخِّر غدًا، والذائقة التي تُدرَّب على الاستهزاء لا تعرف حدًا للتوقف.
ولأن الخطأ جزء من الطبيعة البشرية، فإن تحويله إلى مادة سخرية مضاعفة هو ظلمٌ مضاعف. “تذكّر دائمًا أن الله يكره الذنب، وليس المذنب”. غير أن بعض المؤثرين يخلطون بين الفعل والفاعل، فيدينون الإنسان بدل أن يناقشوا السلوك، ويجرّمون الفئة بدل أن يفهموا الظرف، وهكذا تُنتهك الخصوصية، وتُشوَّه السمعة، وتُختزل الأدوار الاجتماعية العميقة في نكتة عابرة.
ثم تأتي الحقيقة القاسية: “كل ناقص يؤذي الناس بقدر النقص الذي فيه”. فالسخرية هنا ليست شجاعة، بل تعويض؛ ليست ذكاءً، بل قناع، إنها محاولة لملء نقصٍ داخلي بإيذاءٍ خارجي، ولتحقيق حضورٍ رقمي عبر إضعاف حضور الآخرين. والنتيجة مجتمعٌ يتآكل فيه الاحترام، وتُستبدل فيه الحكمة بالتهكم، وتُستنزف فيه القيم لصالح ضحكٍ بلا معنى.
ويبقى القول: النقد حق، والسخرية فن، لكن كليهما يفقد شرعيته حين يُبنى على انتقائية ظالمة، أو يُساق بدافع التكسب. المطلوب ليس تكميم الأفواه، بل ترقية الذائقة؛ ليس محاربة المنصات، بل استعادة البوصلة. فالمجتمع الذي يحمي كباره، ويوقّر آباءه وأمهاته، ويصون معلميه، هو مجتمعٌ يحمي نفسه من السقوط في ابتذال الشهرة. وفي النهاية، ما يبقى ليس عدد المتابعين، بل نوع الأثر؛ وما يُكتب على القلوب أطول عمرًا مما يُسجَّل على الشاشات.