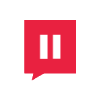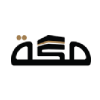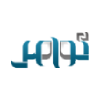اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
د. سوسن العتيبي
من ملامح «إسلاميّة المعرفة» عند «سيد نقيب العطّاس» النظر إلى «اللغة» بوصفها الأساس لإصلاح المعرفة، وفساد اللغة جاء من استقبال الدلالات المفسدة للغة، والتي بدورها تفسد المعرفة؛ لارتباط اللغة بالرؤية الكونية لأي أمة من الأمم، فاللغة عاكسة لهذه الرؤية الكونية؛ وانتقالها من مجال إلى مجال يحدث من خلال اللغة، وما لم يكن النقل واعياً فلن يُفَرَّق بين رؤية كونية وأخرى، حتى داخل ثقافات اللغة الواحدة. وتقدّم (في المقالات عن العلمانية والرؤية الكونيّة) أن «العطّاس» قد أظهر أنّ مدخل فساد المعرفة هو «فساد اللغة»، ومثاله الأبرز ترجمة كلمة «العلمانية»، وقد تقدّم التفاوت بين مستويات من المعاني، التي تتجاوز النقل اللفظي في صلة اللفظ بالمعنى، مع عمق الفجوة بين دلالات تنتمي لذات العائلة اللغوية (التمييز بين النقل السرياني والعربي لترجمة العلمانية)، فكيف بما كان أبعد في العائلة، والزمان، والمكان، وعموم الثقافات؟ وهذا الإفساد اللغوي قد تُغفله مشاريع عدّة لـ «أسلمة المعرفة»، غير مستصحبة للرؤية الكونية الإسلاميّة، من حيث أنّ اللغة انعكاس للوجود في «إسلامية المعرفة»؛ فإسلامية المعرفة أولاً «أسلمة اللغة» لإصلاح «فساد اللغة» قبل نقل العلوم.
وقد أُفسدت مفاهيم فكرية مؤسسة بسبب هذا الفساد اللغوي، منها: من قديم النقل الإسلامي عن اليونان كـ «الفضيلة/ الفضائل»، أو حديثه كـ «الحريّة»، أو عنهما كـ «السعادة». وأهمّ هذه الكلمات في كل الأزمنة، كلمة «العِلم»؛ فقد أُفسد هذا المفهوم المؤسس عندما نقل عبر الأزمنة على أكتاف دلالات تحمله وتوجهه حيث شاءت، فاصلة أو مبعدة إياه عن الرؤية الكونية الإسلاميّة. فدلالة «العلم» في المجال المعرفي المعاصر (المهتم أصالة بالفهم والتفسير في مجال المعاني، والذي يوضع عادة في مقابل «العلوم التطبيقية» في مجال الماديات)؛ تفيد العلم في العلوم عامة، وعلم الاجتماع خاصة، واستُعْمِل مرتكزاً على وصف التحولات الاجتماعيّة، ليدل «عِلم» على التغيّر. في حين العلم في الإسلام يستقي مؤسساته الكبرى من سمات «الرؤية الكونية الإسلامية» (التي تقدم ذكرها في مقال سابق)، ومنها: الثبات، الديمومة، اللاتغيّر. والرؤية الكونية تحلّ سماتها في لغتها، ودلالات مفاهيمها المؤسسة الكبرى، فالرؤية الغربيّة تسم معانيها بـ: التغيّر، واللايقين، والفكرة (لا الحقيقة)، إضافة للأثر المهم لدلالات «التقدّم» و»التغيّر»؛ المحوريين في السياق العلماني. أمّا العلم في الإسلام ليس بحثاً عن التغيّر، وليس وصفاً له، بل هو بحث عن الأسباب التي تغيّر المجتمعات سلباً أو إيجاباً، بموزون القيم، أو بمحددات قيمية معياريّة، تتناسب مع الرؤية الكونيّة للإسلام، محدودة بقيم، نحو: الجهل، الصح، الخطأ... لا كعلم الاجتماع العلمانيّ؛ الذي ينظر للتحولات وصفاً دون معايير تبين قيمة هذه التغيرات في الأخلاق؛ في حين هي في الإسلام بالدرجة الأولى مقدمات لإجراءات التصحيح لهذه التغيرات بالإصلاح. ولا بدّ عند الترجمة، أو استيراد العلوم الغربيّة؛ من الانتباه لدلالة «عِلم» حتى لا يعارض المعيارية الإسلامية (فساد اللغة هو «لا إسلامية المعرفة»)، فإن لم يُنتبه إليها فستستبعد مفاهيم تشتبك مع العلم قيمياً، نحو: عدل، أدب، تأديب.
وأيضاً من المفاهيم المؤسسة التي اقترح إعادة ترجمتها، مع تصحيح دلالاتها، من خلال أساس المعرفة «اللغة»: الحريّة، السعادة، الدين... وغيرها. و»الحريّة»: من حيث أصلها اللغويّ «اختيار»، والاختيار يكون لاختيار الخير دون الشرّ، فالإنسان الحرّ هو المتحرر من أبعاد التبعية للشر، أما اختيار الشرّ فظلم لا حريّة. والمفهوم الثاني «السعادة»، ويراها حالة روحيّة مستمرّة، لا مجرّد شعور لحظي نفسي، أو حسيّ، فهي حالة ترتبط بكل الحياة في عوالمها الدنيا والأخرى، ورأس السعادة محبّة الله، واليقين، ومحصَّل السعادة هو الطمأنينة. فالسعادة حالة «القلب»، وهو العضو الروحي الذي حصّل الطمأنينة من تحصيل اليقين. أمّا المفهوم الغربي للسعادة، فبين مفهوم يوناني قديم يعني: السعادة في هذا العالم، وهي كمال الإنسان المنتهي في كماله فيها. أما في مجمل الدلالة الغربية المعاصرة، فنفس اليوناني من حيث ارتباطه بالعالم المادي، وأنه تحصيل لكمال النفس، لكنه يختلف بأصله النفسيّ لا الاعتبار الخُلقي.
ليُخلص إلى مسلك مهم عند العطاس في إسلاميّة المعرفة، وهو: إصلاح التعليم بإصلاح اللغة، وإصلاح اللغة بإصلاح صلتها بالرؤية الكونية الإسلاميّة، فلا بدّ من معرفة الرؤية الكونية الإسلامية بمؤسساتها العقدية. وأنّ الترجمة أو ما في حكمها ليست ربط لفظ بمعنى، بل هي ربط لفظ بمعنى تحلّ فيه سمات الرؤية الكونيّة، والعكس يفضي لإفساد التعليم؛ لفساد اللغة، انفصالاً عن الرؤية الكونية الإسلاميّة.