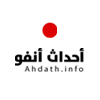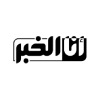اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٤ شباط ٢٠٢٥
أكد عياد أبلال أن اللقاء الفكري الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى بالرباط، يعكس نضج الدولة في التوفيق بين الديني والسياسي، ويتماشى مع النقاشات الفلسفية العالمية حول إصلاح الحداثة من خلال الدين والأخلاق، كما يسبق التحولات الدولية الجارية في هذا المجال.
وأشار أبلال إلى أن الفكر الفلسفي في الغرب والشرق يتجه نحو العودة إلى الدين والأخلاق لإنقاذ الإنسان من العنف والاستغلال، مؤكدًا على أهمية التوحيد بدل التجزئة، ودمج علوم الإنسان والطبيعة، مستشهدًا بدعوات إيمانويل فالنشتاين وطه عبد الرحمن في هذا السياق.
وأكد المتحدث في حوار مع جريدة 'العمق المغربي'، على ضرورة تجاوز الخطاب السياسي التقليدي القائم على الولاء والمحسوبية، واستبداله بمنظومة سياسية قائمة على الكفاءة والتقوى والاستحقاق، مشددا على أهمية تحويل هذه القيم إلى مرجعيات أساسية في التشريع والحكامة الرشيدة.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
ما هي الدلالات والرسائل التي يمكن استخلاصها من فتح المجلس العلمي الأعلى لهذا النقاش الأخلاقي والسياسي، بحضور ممثلي مؤسسات الدولة؟
بداية إن اللقاء الحواري الفكري الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى يوم التاسع من فبراير 2025، في سياق خطة 'تسديد التبليغ' بالرباط، وجمع رجالات الدولة من كل الأطياف حول وحدة الديني والسياسي، ووحدة الملكية وإمارة المؤمنين، هو لقاء ممتع ومؤشر إيجابي على رجاحة عقل الدولة وترصيف لطريق الحكمة والرشد. وهو لقاء يساير مستجدات الحقل الفلسفي والفكري العالمي بالدعوة إلى إصلاح الحداثة عبر الدين والأخلاق، ويستبق هذا الطرح على المستوى العربي مبادرات قد تأتي في سياق التحولات الدولية الجارية.
عنوان اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى: 'تسديد التبليغ' يذهب في سياق تقليص الفجوة ما بين الدين والتدين على كافة مستويات الحياة اليومية للمغاربة، من خلال التأهيل الأخلاقي في بعده السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي. وهذه الرسالة الأولى من وراء هذا اللقاء.
لقد شكلت عودة الديني في مختلف صيغه في الغرب عدة تجليات تتمثل في العودة إلى الأخلاق والروحانيات. وإذا كانت هذه العودة قد جاءت من خلال إعادة تفكيك الحداثة، فإنها لم تستطع النفاذ إلى عمق الإشكالية، حيث الأساس الإبستيمولوجي للحداثة يكمن في الوضعية كنظام معرفي أُسِس على الفصل الهدام، فصل الدين عن السياسة، فصل الأخلاق عن القانون، فصل الجسد عن الروح، فصل العلم عن الدين.
ولذلك، جاءت جهود ما بعد الحداثة لتنظيم الفوضى المعرفية وإعادة تدويرها، دون أن تمتلك الجرأة والشجاعة على تفكيك الأسس الإبستيمولوجية لنظام الوضعية المنطقية في أبعادها المختلفة. في حين تمتلك المعرفية الإسلامية، كنظام معرفي 'قيد البناء والتشكل'، إمكانية إصلاح الحداثة من خلال مساءلة أسسها الإبستيمولوجية.
فإذن، يتضح من خلال أهم التيارات الفكرية والفلسفية في الغرب كما في الشرق، أن العودة إلى الدين والأخلاق هي ربما آخر محاولة لإنقاذ الإنسان من جبروت الغريزة والعنف والاستغلال، عبر العودة إلى الروحانيات والأخلاق ومصالحة الجسد مع الروح. وهو ما يقتضي العودة إلى الوحدة بدل التجزيء، وإلى الوصل بدل الفصل.
الرسالة الثانية تتأسس على أهمية هذه العودة في سياق مغربي يتسم بتحولات اجتماعية وسياسية تتطلب تأصيل النقاش الأخلاقي والسياسي من منظور ديني. فالمغرب يواجه صراع التأويلات والرؤى حول مدونة الأسرة وتعديلاتها، حيث انقسم إلى تيارين: تيار حداثي يحاول إبعاد الدين عن هذه المدونة، بدعوى الانتصار للمرأة والمساواة، وتيار آخر ينتصر للخصوصية المغربية القائمة على الدين والأخلاق الأسرية. وبين هذين التيارين، تأتي مبادرة المجلس العلمي الأعلى كدعوة لإعادة التوازن بين الدين والقانون، بما يعزز الوحدة الأخلاقية والقانونية في المجتمع.
الرسالة السياسية الثالثة، هي أن العودة إلى التأسيس الأخلاقي والديني للقانون والقضاء والاجتماع يقتضي إعادة النظر في السياسة الجنائية ببلادنا، على أساس مبدأ الائتمانية والوصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة. فالقاضي، ورجل الأمن، والخبير في الطب، ووكيل النيابة العامة، والمسؤول في الإدارة الترابية وفي مؤسسات الدولة كافة، يجب أن يخضعوا في عملهم لمبدأ النزاهة والتزكية، بربط عملهم بمبدأ المسؤولية الائتمانية، التي ليست في النهاية سوى مراعاة الفطرة والأخلاق، بوصفهما أساس الدين.
إن انتصار العقل الأداتي-المؤسساتي الرسمي، هو انتصار للقانون، بيد أن هذا الانتصار في سياق الحداثة هو انتصار للقوة والتمكين، وليس انتصارًا للأخلاق. ومن المعلوم أن التشريع القانوني يخضع في سياق الحداثة إلى القوة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، بمعنى أن القوي هو من يتولى التشريع وينتصر لمصالحه، بدل الانتصار إلى الرأفة والإحسان والتزكية والضمير. وهنا يجب التذكير بالصراع الحاصل مؤخرا على مستوى حرية التعبير، وحدودها وأشكالها وصيغها، وما يرتبط بباقي الحريات والحقوق، خاصة وأن من يملك القوة السياسية يملك القدرة على التشريع.
لذلك، فمبادرة المجلس العلمي الأعلى تأتي من منظور فكري وفلسفي في سياق إعادة تعريف دولة الحق والقانون على أساس أخلاقي، وهذا انتصار كبير لإعادة تعريف مفهوم الدولة ومفهوم الوطنية. وهو ما يقتضي تعميق النقاش الفكري لبناء مشروع مجتمعي على أساس عقد اجتماعي جديد ينتصر للمواطنة الائتمانية.
كيف يمكن لهذا النقاش أن يساهم في التأسيس للوحدة الوطنية على أساس العلم والمعرفة والحوار، مع مراعاة الدور المركزي للدين والأخلاق؟
إن الائتمانية المستعارة من مشروع طه عبد الرحمن الفلسفي، تصب في جوهر 'تسديد التبليغ' الذي يعتبره المجلس العلمي الأعلى عنوان مبادرته هذه. فتسديد التبليغ، معناه في الفقه، هو تصحيح منهج تبليغ الدين من أجل الاهتداء إلى منهج التقوى المتناغم مع جوهر الدين وأساسه. ولذلك، يمكن اعتبار هذه المبادرة شكلاً من أشكال هذا التصحيح، طبعا إذا ارتبطت بتكثيف مناهج التسديد وآلياته، حتى لا يبقى تسديداً نخبوياً ومؤسساتياً بعيداً عن المجتمع وعقله. وهنا وجب استحضار علاقة تسديد التبليغ بمؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام.
ولربما جاز لنا أن نستحضر مفهوم ثقافة الأم لعبد الله العروي في كتابه الاستبانة، ذلك أن تقليص الهوة بين الدين والتدين وفق بعد أخلاقي يتأسس على مفهوم التربية. وهو ما يقودنا إلى تعميق التأويل الأنثربولوجي الرمزي لهذه المبادرة، بوصفها دعوة لإعادة النظر في المشروع التعليمي والتربوي والإعلامي في بلادنا، ذلك أن أزمة القيم في التعليم والإعلام تجعل كل حديث عن تسديد التبليغ فاقدة لكل معنى. وهذه هي الرسالة الرابعة.
لكن هذا النقاش الفكري، لا يجب أن ينسينا، سياقه السياسي العام، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تعيشها بلادنا على مستوى وحدتها الترابية واستحقاقاتها في الاقتصاد والسياسة والتنمية، بما يستلزم التأسيس للوحدة التاريخية بتعبير الراحل محمد عابد الجابري رحمه الله. لكن بين الوحدة التاريخية المفقودة بين الأحزاب والنقابات والمؤسسات السياسية، بما في ذلك الحكومة، والمجتمع المدني وعموم المجتمع، تتأسس معرفيا إشكالية من يحكم؟ ومن يُشرع، وكيف يحكم وكيف يُشرع؟
وهنا نكون في صلب النقاش السياسي والدستوري، ولذلك فالاختلاف في التأويل بين المخزن والمؤسسات والشعب يخضع وجوبا للاختلاف في وجهات النظر وفي الرؤى للعالم والأشياء، بما يقودنا حتما نحو استحضار مفهوم مركزي وهو عقل الدولة، المتشكل من رجالات الدولة والسياسة والاقتصاد، حيث تحظى إشكالية التنخيب بأهمية تحليلية ومنهجية مهمة، غالبا ما يتم تجالها في دراسة النسق السياسي المغربي، فالأزمة بداية وانتهاء ليست في المخزن أو في الدولة، بقدر ما هي أزمة نخب، ومدى ائتمانيتها الأخلاقية والدينية تجاه الشعب.
ولهذا فتحميل وزر الأخطاء الجسيمة في التنمية والعدالة الاجتماعية للمخزن يعتريه خلل وظيفي وتحليلي، بالنظر إلى مسؤولية الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية منذ الاستقلال إلى اليوم، ولنا في فشل أوراش التنمية المرتبطة بالجماعات الترابية والحكومات المتعاقبة خر دليل على أن اختزال أعطاب النسق السياسي في مفهوم المخزن، هو معطى يثير الكثير من الغموض والشك المنهجي، إذ التحليل الأنثربولوجي الرمزي للغة هذه النخب يقودنا نحو استخلاص معجم يفتقد للمرجعية الدينية والأخلاقية، مثلما يفتقد لأخلاق المواطنة، فالهمزة، والريع والمصالح الشخصية والأنانيات المفرطة، و'دير علاش تولي'، و'الحلاوة'، و'التغياز'…إلخ، تشكل لغة التواصل اليومي وفق تطبيع ثقافي ومجتمعي مع الفساد.
وعلى هذا الأساس، فالنضال السياسي وفق تسديد التبليغ، يجب أن يحسم مع المعجم التقليداني المفتقد لأخلاق المواطنة والعناية بشكل نهائي، ويرتكز على كفايات روحية وأخلاقية، أساسها الكفاءة لا الولاء، التقوى والتزكية لا النسب والحسب، المجهود والاستحقاق لا الريع والمحسوبية، وهو ما لا يمكن أن يتأسس ويتبلور دستورياً وسياسياً دون تحويل هذه القيم والأخلاق إلى خلفية مرجعية حقيقية للتدبير والحكامة الرشيدة، وعلى رأس ذلك التشريع القانوني والتدبير الأمني والقضائي.
الأمر الذي يجعل مسؤولية التربية في الأسرة والمدرسة والجامعة وفي الإعلام مسؤولية جسيمة، ففي النهاية، فعقل المجتمع يغذي بشكل غير مباشر عقل الدولة، والحكومات بالنهاية هي مرآة شعوبها، وكيفما تكونوا يولى عليكم. ولا يجب أن نخرج من الدولة ضد المجتمع إلى المجتمع ضد الدولة، ففي كل الحالات يجب أن يتحقق التحالف بين العقلين لصالح سعادة الموطنين وازدهار العمران.
هل ترون أن هذا اللقاء يمثل خطوة نحو تجديد عقل الدولة، وهل يمكن أن يؤدي إلى حوار وطني شامل على قاعدة عقد اجتماعي جديد وعقد فكري وفلسفي؟
تأسيساً على ما سبق، أعتقد أن هذه المبادرة، حتى لا نكون عدميين، هي مبادرة خلاقة لتجديد عقل الدولة، وتأسيس عقد اجتماعي جديد، يتجاوز السياسي والاقتصادي في غلبتهما على باقي الأنساق التأسيسية للاجتماع والعمران في المغرب، ولكن شريطة انفتاح عقل الدولة هذا على مستلزمات العقل في المعرفية الإسلامية. فالعقل هنا، ليس فقط تجريبياً مادياً، أي يحتكم للحداثة السياسية والتقنوية الاقتصادية الفجة، بل عقل تأملي عرفاني وأخلاقي، حيث مركزه الروح وليس المادة، بمعنى آخر، إن هذا العقل هو ثقافي وفكري، ديني وأخلاقي وليس فقط عقلا سياسياً واقتصاديا. عقل يتأسس على الوصل بما هو صلة رحمية، وليس الفصل بين الحكام والمحكومين، حيث الآخر هو صورة الذات في مرآة الأخوة الإنسانية والمواطنة.
لقد أهدر المغرب الكثير من المحطات والمبادرات بسبب عقل الدولة المنغلق على ذاته، والتمركز حول الإدراك السياسي السلطوي للدولة المخزنية نتيجة تضرر الثقة السياسية بين الفرقاء، بدل الإدراك العاطفي والوجداني، والأخلاقي، حيث العدل والإحسان سمة الدولة الائتمانية، خاصة أمام ما يعرفه العالم اليوم من سيولة مادية في الأخلاق والقيم وفي العلوم والمعارف، حتى صارت الإنسانية كلها سائلة تنتصر للمادي على حساب الروحي، فغلبة الماديات والانتصار للأنانية والفردانية المغرضة، هو من يشرح إلى حد كبير النهب والسرقة والاحتيال والاستغلال والظلم، حيث المبتغى هو مُلك لا يبلى، وحيث لا يروي تعطش الناس للمِلكية والنفوذ بلا حدود سوى المزيد من الظلم والفساد، وحيث لا يمكن للقانون لوحده أن يحد مطامح الناس وانفجار أهوائهم وغرائزهم.
وهذا لا يعني أن الدولة يجب أن تكون أخلاقا بلا قانون، وإلا استحال وجودها، بل المقصود أن القانون في كل الأنظمة يمكن التلاعب به واستغلال فجواته، واستغلال النفوذ في التشريع بما يرضي أهواء السياسيين وغرائزهم، كما يحدث في سياق النيوليبرالية اليوم، ليس في المغرب فحسب، بل في كل البلدان، مع الفارق في الدرجة والنوع وقوة القانون ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والحقوقي. ولهذا فمحاربة الفساد ليست فقط مسؤولية الدولة ومنوطة بالقانون فحسب، بل هي مسؤولية ائتمانية وطنية.
وهنا أتفق مع السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، حين قالت بأن محاربة الفساد واجب شرعي ووطني، وإذا كانت لم تشر إلى إشكالية الولاء والأهلية على حساب الكفاءة والتقوى، فقد اعتبرت أن الحل هو في اختيار الشخص المناسب، في سياق التكامل ما بين الفاعل التنموي سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً والفاعل الديني باعتبار محاربة ظاهرة الفساد المالي مسؤولية مشتركة وواجب وطني شرعي، وهو ما لا يختلف حوله كل ذو عقل لبيب.
إن غياب الائتمانية في تاريخ الممارسة السياسية في المغرب المبنية على أسس دينية وأخلاقية، جعل عقل الدولة، بالرغم من تجدده الشكلي الدائم منغلقاً في الثقافة المخزنية التي صارت، مع الوقت، بنية من بنيات المتخيل الشعبي، حتى أنها تحولت بفضل الإعلام والممارسة السياسية اليومية إلى ثقافة شعبية، حيث الولاء بدل الكفاءة، وحيث القرب بدل البعد، وحيث الريع بدل المجهود والاستحقاق، وحيث الانتساب والنسب بدل التقوى والتزكية.
ولذلك صارت الدولة تغذي عقلها بالشبيه والمماثل، حيث بدأ النسق يولد النسخ وتكاثرت النسخ حتى صرنا نحو المطابقة، وهو ما يعني أن المجتمع تَطَبع مع هذه الثقافة التي لم تكن مجرد أشخاص بالرغم من دورهم في ترسيمها وتكريسها كنسق مرجعي، خاصة إذا توفرت للأشخاص أدوار ومكانة في النسق السياسي.
ما هي التحديات والصعوبات التي قد تواجه هذا المسار، وكيف يمكن التغلب عليها؟
إن الحديث عن تجديد عقل الدولة بالانتصار للوحدة التاريخية، لا يجب أن يُفهم كهروب نحو العقل الأخلاقي والديني، بعد فشل العقل القانوني، بمعنى أن هذه المبادرة لا يجب أن تُفهم كفشل للدولة في تطبيق القانون والانتصار لدولة الحق، بل بالعكس تماما، فالقانون يجب أن يعلو ولا يعلى عليه، إذ يجب أن تمارس مؤسسات القضاء كامل صلاحياتها القانونية والدستورية في ظل احترام فصل السلطات واستقلاليتها الدستورية.
ولهذا فوصل القانون بالأخلاق والدين على مستوى العقل العملي، يجب أن يتأسس على قوة القانون في المجتمع، وليس على الخوف من القانون، على سواسية المتقاضين وليس على التفضيل والحصانة، حيث لا يجب أن يكون في المجتمع من هم بعيدون عن المساءلة، مهما كانت المناصب والانتماءات. وهنا تأتي مهمة الوصل بالأخلاق والدين، حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة يتجاوز البعد السياسي نحو البعد الائتماني، وحيث ربط عالم الغيب والشهادة، يجعل القانون يزداد قوة، وهو ما يجعل المجتمع يتمثل الدولة تمثيلاً إيجابياً. فإذن الصعوبات تتجلى في كيفية جعل العقل العملي يتأسس، تربوياً وقانونياً، على مفهوم المسؤولية والأمانة.
لكن هذه الغاية يجب أن تنطلق من موقع القوة لا الضعف، حيث يجب على الدولة أن تمتلك القوة الكافية والإرادة الكفيلة بجعل القانون يعلو ولا يعلى عليه، خاصة في ظل انتشار ثقافة التشهير والنيل من الرموز الوطنية وهبة الدولة، وهو ما يضر بعقل الدولة والمجتمع على حد سواء، مما ينتج عنه ما أسميه بالمجتمع الفضائحي والتلصصي La Société inquisitionnelle.
لكن هنا لا يجب تحميل المسؤولية فقط لعقل الدولة، بل منشأ انتشار التفاهة والفضيحة وترميز التفاهة يعود بالدرجة الأولى لعقل المجتمع، فبغياب هذا العقل، المتكون من المثقفين والمفكرين والعلماء والمبدعين، يُرَمِز المجتمع التفاهة ويخلق منها قدوة ومثال، ولنا في شبكات التواصل الاجتماعي خير دليل على ذلك، فالمجتمع في غياب عقل المثقفين والمفكرين والفلاسفة والعلماء، يتحول من مجتمع من أجل الدولة إلى مجتمع ضد الدولة، نتيجة تدمير الأخلاق ونفي الدين.
وعليه، فالترميز المجتمعي يجب أن يخضع لشرط الأخلاق الائتمانية، على أني أوظف هنا الأنثربولوجبا التأويلية الرمزية في تفكيك المتخيل الجمعي في بنائه للرموز، فعقل الدولة كما عقل المجتمع مجبولان على صناعة الرموز والعلامات. ولذلك يجب أن يحدث تناغم ما بين رموز المجتمع من مثقفين ومفكرين وإعلاميين وفنانين ورموز الدولة من قيادات ورجالات الدولة في مجالات السياسة والاقتصاد والقضاء والحقوق، وفق جدلية ائتمانية تؤسس الوصل بينهما على أساس أخلاق الوطنية والانتماء والهوية الجامعة، أو تمغربيت، وإشاعة ثقافة الاعتراف.
ولهذا، فالوازع الديني والأخلاقي مطلوب وجوهري في كل المقاربات الإصلاحية، لكن في توافق كامل مع سلطة القانون، وهو ما أكده السيد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمته حينما استشهد بالقاعدة الشهيرة للخليفة عثمان بن عفان:' إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيمان'.
ما هي أهم القضايا التي يجب أن يتناولها هذا الحوار الوطني، وما هي الأولويات التي يجب التركيز عليها؟
إذا كانت هذه المبادرة تقتضي حواراً وطنياً يعقبه اجماع مجتمعي على المشروع المجتمعي المأمول، فإن الأمر يتطلب النقاش المجتمعي المفتوح حول قضايا العدالة الاجتماعية، والجبائية، والسياسة الجنائية، والمواطنة، والحريات الني تضمنها المواثيق الدولية، وقبل هذا وذاك، نظام التمثيلية السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذه المواضيع كلها تتأسس على الأهمية المركزية للانفراج السياسي، الذي يقتضي الافراج عن كافة معتقلي الرأي والسياسة، وهي أولوية مركزية بالنظر إلى أن هذا الحوار يقتضي أخلاق العناية والشجاعة، وليس الخوف، فالخوف يربي النفاق والأنانية والجشع والتملق، وإذا اشتد التملق والمهادنة اعلم، كما يقول ابن خلدون، أنه اشتد الظلم والجور والقهر، فالشعوب المقهورة تسوء أخلاقها، وهو إيذان بخراب العمران.
إن المشهود إذن أن الثقة السياسية قد تضررت كثيرا بسبب الفشل في التنمية والانتقال الديموقراطي الذي طال كثيرا، خاصة بسبب خلل وظيفي أصاب عقل المجتمع، وأقصد النخب الثقافية والفكرية والسياسية والنقابية، مما أدى إلى تضخم مستويات الفردانية والأنانية واستغلال المواقع من أجل المصالح الشخصية على حساب المجتمع، واشتد الجور والقهر، خاصة تجاه الفقراء والبسطاء.
مما يجعل الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة تتضرر بشكل جسيم، وهو ما ينعكس على الصحة النفسية للمغاربة، ولا غرو إن وجدنا حسب آخر الدراسات أن نسبة المغاربة الذين يعانون من مشاكل واضطرابات نفسية تقترب من عتبة 50 في المئة، وهذا رقم خطير، بيد أن تحقيق سعادة الناس غير مرتبطة فقط بما هو دنيوي ومادي صرف، بل بما هو روحي وديني، فالإيمان والدين والأخلاق مرتكزات أساسية للصحة النفسية الإيجابية، وهو ما تؤكده الدراسات المعاصرة.
ولذلك فالعودة إلى التدين المقرون بالتقوى والتزكية والمسؤولية الإيمانية كفيلة بتقليص هذه النسبة المرتفعة لتضرر الصحة النفسية للمغاربة، وهو ما تناولته كلمة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق في هذا اللقاء. وإن كنت من الذين باتوا يؤمنون أشد الإيمان بممكنات الدين والأخلاق في إصلاح أعطاب الحداثة، فإني أعتبر مواعظ ووصايا وإشارات القرآن الكريم، وفلسفته في النفس البشرية كفيلة بذلك، بل وتتجاوز أعطاب وأوهام الحداثة كما تجلت في علم النفس الغربي.
لكن هذا الوازع الديني والأخلاقي مطلوب ومرغوب للوقاية كما في العلاج، لكن بشرط أن يكون مقروناً بانتعاش البنيات الطبية والصحية التحتية من مستشفيات ومراكز استشفائية وعلاجية وتيسير الولوج إليها في سياق دعم الصحة في المغرب، وهو ما يرتبط جدلياً بمدى نجاح الإصلاح وأوراش التنمية، وهذا عينه الهدف من تسديد التبليغ، حيث مقصده الأساس سعادة الناس وازدهار العمران.
كيف يمكن للمثقفين والمفكرين والخبراء أن يساهموا في إنجاح هذا الحوار الوطني، وتقديم رؤى واقتراحات عملية؟
يقودنا التحليل الموضوعي لعقل الدولة إلى استخلاص أن الانغلاق الذي حصل لهذا العقل منذ الاستقلال إلى اليوم كان نتيجة شيخوخة أصابت عقل المجتمع، باستثناء مرحلة الستينيات والسبعينيات، ولو أن هذا العقل كان ضحية الثنائيات الهوياتية القاتلة على المستوى السياسي، الحداثة مقابل التقليد، المخزن مقابل الأحزاب، اليسار مقابل اليمين.
وعلى المستوى الاجتماعي الأغنياء مقابل الفقراء، الرجال مقابل النساء، وعلى المستوى الثقافي: المثقفون والمفكرون مقابل الفقهاء، وهو ما أسس لتراتبية طبقية ومعرفية تغذت على النفور المعرفي والعداء الاجتماعي، وقد كان هذا التنافر، جزئياً، تجلٍ من تجليات الصراع الإيديولوجي العالمي بين القطبين.
وعلى هذا الأساس، وجد عقل الدولة نفسه ملزما على لعب دور الناظم المركزي بين هؤلاء المختلفين، وبين هذا وذاك، وجدت الدولة المخزنية نفسها ملزمة بملء الفراغ في تدبير السلطة والحكم أمام تنازع الشرعيات والمرجعيات. طبعا أمام تغييب عقل المجتمع وانغلاق عقل الدولة في سياق الصراع الذي وسم سنوات الجمر والرصاص، صارت الدولة، بعد التقويم الهيكلي والفساد الإداري والمالي، ملزمة بتطبيق المقاربة الأمنية، خاصة بعد أن تعمقت مستويات التبعية للغرب اقتصادياً وسياسياً، ذلك أن تدبير الواقع والممكن يجب أن يخضع شرطياً لاستحضار مفهوم السيادة والتبعية، وهو ما يجعل الاختلاف في تدبير السلطة والحكم يخضع لاختلاف التأويل وترتيب الأولويات.
بمعنى آخر، إن من هو داخل السلطة والحكم ليس كمن هو خارجهما، بيد أن الاختلاف في التأويل والخطاب لا يجب أن يجعل عقل الدولة، كما عقل المجتمع، ينزع نحو نفي الصراع والتدافع، بدعاوى التخوين وغياب الأهلية السياسية، لأن التدافع وإرادة التغيير من سنن الله في الوجود والخلق. وأعتقد أن حجب الصراع ونفي الاختلاف قد حرم المغرب من العديد من الفرص التاريخية. وهنا المسؤولية جماعية وليست فردية، ففي النهاية التغيير المجتمعي هو دوما تغيير جماعي، وليس فردياً ولن يكون مهما كانت النوايا حسنة. وهنا أتفق تمام الاتفاق مع السيد عبد النبوي، في أن' العدالة منتوج مجتمع يحكمه الوازع الأخلاقي وليست مسؤولية القاضي وحده، فالعدالة تكون منتوجاً مجتمعياً من خلال شيوع الأخلاق الفاضلة'
إن النقد الثقافي والفكري للمشروع السياسي يجب أن يتأسس على قاعدة الائتمانية والأخلاق. ولذلك فدور المثقفين والمفكرين والعلماء والباحثين مهم في تغذية عقل الدولة تغذية راجعة، وهو ما يحتم إعادة الاعتبار للمثقف في أداء دوره في النقد والتقويم من منظور حواري وأخلاقي.