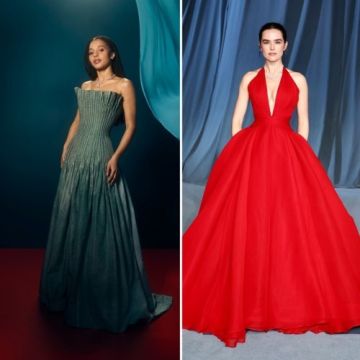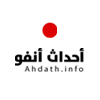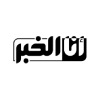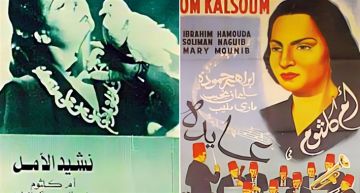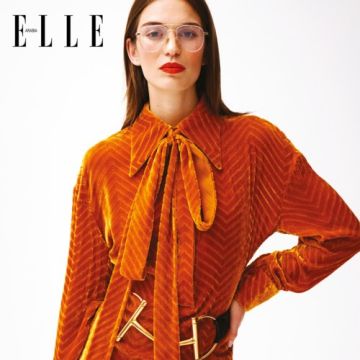اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
في زمن تتسارع فيه وتيرة المعلومات وتغمرنا الصور الرقمية على مدار الساعة، يجد الجيل الجديد، المعروف بجيل «زد» (Z)، نفسه أمام تحديات غير مسبوقة في علاقته بالتعلم والمعرفة، لذا تطرح الكاتبة بريجيت بروت في كتابها 'Génération Z – Libérer le désir d’apprendre'، الذي نقدم قراءة له، سؤالا جوهريا يمس صميم واقعنا ومستقبلنا: لماذا فقد هذا الجيل شغفه بالمعرفة والاكتشاف؟ وكيف يمكن إعادة إشعال رغبة التعلم لديه في عالم يركض بلا توقف، ويستهلك بسرعة، ويغمره سيل لا ينتهي من المحتوى الرقمي؟
يأخذنا النص في رحلة تحليلية معمقة، تحاول فك رموز هذه الأزمة التعليمية والثقافية، مستندة إلى تجارب ميدانية وأبحاث علمية وشهادات متنوعة، لتقترح رؤى وأفكارا قادرة على إعادة بناء جسر التواصل بين المعرفة والجيل الجديد. هنا، لن نتوقف عند وصف المشكلة فحسب، بل سنستكشف أيضا الطرق الممكنة لإعادة الحيوية لشغف التعلم، في سياق يتطلب من الأجيال القادمة التكيف والابتكار والتفكير النقدي، بعيدا عن اللامبالاة الرقمية.
وتطرح الكاتبة برجيـت بروت في كتابها 'Génération Z – Libérer le désir d’apprendre' إشكالية كبرى تكاد تكون مركزية في عصرنا: لماذا فقد الجيل الجديد، المسمى جيل Z، شغفه بالتعلم ورغبته في المعرفة؟ وكيف يمكن إعادة إشعال هذه الرغبة في عالم مشبع بالسرعة والاستهلاك والصور الرقمية المتدفقة؟
الكتاب ليس دراسة جامدة، بل هو شهادة شخصية وتربوية عميقة ونتاج مسار الكاتبة كأستاذة للأدب قبل أن تتحول إلى 'محفزة للتعلم' (profession motivatrice). فقد خبرت من داخل الفصول الدراسية كيف ينفصل التلميذ عن قدراته، وكيف يضيع بين الإمكانات الكامنة والنتائج المتواضعة.
في لحظة وعي صادمة، رأت أن كثيرا من التلاميذ يملكون طاقات ضخمة لكنها لا تجد طريقها إلى التحقق. تقول: 'كل طفل يحمل في داخله طاقة لا يستطيع هو نفسه ولا الآخرون قياسها'. من هنا نشأ مشروعها التربوي: مرافقة الشباب، لا لزرع الحافز فيهم من الخارج، بل لمساعدتهم على اكتشاف ما هو موجود بالفعل في داخلهم.
وترى بروت، أن التعلم فعل إنساني مؤسس، أي أن الإنسان يتحدد من خلال ما يتعلمه ومن خلال علاقته بالمعرفة. غير أن هذا الفعل اليوم محاصر بتناقضات المجتمع الحديث. فجيل Z يعيش في ثقافة 'الكل، والآن، وفورا'، فالسرعة أصبحت معيارا، واللحظة اختزلت الزمن، والصورة حلت محل المعنى، بل حتى العلاقة بالتربية تبدّلت حيث لم تعد المعرفة تنتقل عموديا من جيل إلى آخر، بل أصبحت أفقية ومتشظية، ولم يعد واضحا من يربي: الأسرة أم المدرسة أم الشبكات الاجتماعية؟، هذه الوضعية تجعل الشباب يطلقون صرخة خفية: 'أنا موجود، أنقذوني!'. إنها صرخة بحث عن أفق ومعنى، قبل أن تكون صرخة احتجاج.
العلاقة بالمدرسة وأزمة الهوية
في قلب هذه التحولات، يطرح الكتاب ثلاث قناعات أساسية تؤطر رؤية المؤلفة. الأولى أن كل طفل جاء إلى العالم ليعطي شيئا خاصا به. لكل فرد رسالة، سواء في الفن أو العلم أو الحياة اليومية.
الثانية أن كل إمكانات الإنسان لا يمكن اختزالها في اختبارات أو تقييمات، بل هي قابلة دوما للتفتح إذا وجدت الظروف المناسبة. والثالثة أن الطفل والمراهق قادران على تحمل المسؤولية بما يتناسب مع عمرهما، شريطة أن يُعترف بهما كشخصين كاملين في طور التكوين. هذه الرؤية الإنسانية تجعل من التربية ليس مجرد تدريب على المهارات، بل مشروعا لتمكين الشخص من أن يكون ذاته.
لكن هذه القناعات تصطدم بواقع اجتماعي وتربوي مقلق. فالمراهقون يوصفون اليوم بأنهم 'بالغون مصغرون' تطلب منهم الاستقلالية باكرا لكنهم محاطون في الوقت نفسه بالمساعدة المفرطة. يُربون على الاستهلاك، وعلى النرجسية الرقمية، وفي الوقت نفسه يُنتظر منهم أن يحافظوا على الجدية الدراسية. هنا يظهر التناقض العميق: كيف يمكن أن يتعلم شاب وهو يعيش في منطق المتعة الفورية؟ كيف يمكن أن يستوعب معنى الجهد بينما كل شيء من حوله يدعوه إلى السهولة والسرعة؟ تقول بروت: 'التعلم والاستهلاك: كل شيء وضده'.
نتيجة لهذا التناقض، تتحول العلاقة بالمدرسة إلى أزمة هوية. كثير من التلاميذ يسألون بصدق: 'ما الفائدة؟'. ليس سؤال كسل بل سؤال معنى. المدرسة، كما هي اليوم، تبدو منفصلة عن واقعهم، عن عالمهم الرقمي والآني. وهي، بدل أن تمنحهم أدوات لفهم هذا العالم، تزيد من شعورهم بالضغط والاغتراب. تضيف الكاتبة أن ما يُنتظر من التلميذ المثالي لا يطابق صورة التلميذ الواقعي. هذه الفجوة تخلق إحباطا متبادلا: التلميذ لا يجد نفسه في المدرسة، والمعلم يقول: 'لم نعد قادرين عليهم'.
لكن بروت لا تسقط في التشاؤم. فهي ترى أن الحل يكمن في إعادة بناء علاقة جديدة مع التعلم، علاقة تقوم على الإصغاء والاعتراف والوضوح. فالدافعية لا تُفرض، بل تُبنى. لا توجد وصفة جاهزة للتحفيز، بل هناك شروط ينبغي تهيئتها: إطار منظم يحدد القواعد بوضوح، نتائج ملموسة تمنح التلميذ شعورا بالإنجاز، وتشجيع على التعلم التعاوني الذي يحول القسم إلى فضاء للتبادل والدعم المتبادل، وأخيرا الاعتراف بمكانة التلميذ كشخص عاقل وناضج يستحق الاحترام.
في هذا السياق، تروي بروت قصصا عديدة من تجربتها. أحد التلاميذ يقول: 'لا أستطيع أن أبدأ'، وهي عبارة تكشف أن المشكلة ليست في القدرات بل في غياب الأدوات المنهجية. طالبة أخرى كانت ترفض مراجعة دروسها في البيت لأن والدها عاطل عن العمل منذ فترة، وكانت تعتبر أن تعلمها نوع من الخيانة له. هنا لم يكن الحل نفسيا ولا طبيا بل تربويا: تمكينها من المراجعة في فضاء آخر غير المنزل. هذه الأمثلة تؤكد أن فقدان الدافعية ليس عجزا ذاتيا، بل انعكاس لسياق اجتماعي أو عائلي يحتاج إلى إصغاء.
الجانب الأكثر ثورية في الكتاب هو قول الكاتبة إن الدافعية نفسها يمكن أن تُعلَّم. تقول إحدى تلميذاتها في الصف السادس: 'يمكن تعلم التحفيز!'، وهو ما تعتبره المؤلفة نقطة انطلاق لأي مشروع تربوي. أدوات مثل التقييم ومسار التحفيز تسمح للتلميذ بتحديد مكامن قوته وصعوباته، الطقوس اليومية تساعده على بناء تركيزه، والتربية على الصبر والإحباط تمنحه قدرة على مواجهة الفشل. باختصار الحافز ليس معطى ثابتا بل مهارة تُبنى مع الزمن.
ولكي تُوضح هذه الفكرة، تستعرض بروت سبعة مسارات لتلاميذ يعانون من أشكال مختلفة من الإحباط: 'مارين التي لا تريد النجاح ولا الفشل، وألكسيس الذي يعتقد أنه 'فاشل' في الأقسام التحضيرية، وإيما التي تقول: 'لا أحب تكرار الشيء نفسه، إنه ممل'، وغيرهم. هذه الحالات تكشف أن لكل تلميذ قصة خاصة، وأن التحفيز لا يمكن أن يكون عاما، بل يجب أن يكون شخصيا ومبنيا على الإصغاء والفهم.
ثورة تربوية وبيداغوجيا جديدة
في النهاية، تدعو بروت إلى ثورة تربوية هادئة: بناء بيداغوجيا جديدة للثقة والتعقيد. التربية يجب أن تهيئ الشباب لمواجهة عالم معقد لا يمكن اختزاله في إجابات بسيطة. يجب أن يمارس الراشدون 'سلطة عادلة'، أي سلطة تحمي وتوجه لكنها لا تقمع ولا تستسلم. يجب تعليم الشباب معنى الجهد والانتظار، بدل البحث الدائم عن المتعة الفورية. ويجب أن تتحول العلاقة بين الأسرة والمدرسة إلى شراكة حقيقية، لأن تربية جيل جديد ليست مسؤولية مؤسسة واحدة، بل مشروع جماعي.
الكتاب يختم برسالة واضحة: الأطفال والمراهقون اليوم يطلقون صرخة: 'النجدة، أنا موجود'. إنهم يطلبون من الكبار أن يعترفوا بوجودهم، أن يمنحوهم أفقا ومعنى. الرغبة في التعلم ليست في حكم المفقودة، لكنها تحتاج إلى أن تتحرر من القيود التي تفرضها ثقافة الاستهلاك والسرعة، لـن إعادة تحرير هذه الرغبة هو مشروع حضاري، يتجاوز المدرسة ليطال المجتمع كله.
بهذا المعنى، فإن مؤلف بريجيت بروت ليس مجرد كتاب عن التعليم، بل هو دعوة لإعادة تأسيس العلاقة بين الأجيال. الجيل الجديد لا ينقصه الذكاء ولا القدرة، بل يفتقر إلى الإطار والمعنى. إذا استطاع الراشدون (الآباء والمعلمون والمجتمع) أن يقدموا هذا الإطار، فإن الطاقة الكامنة لدى الشباب ستتحول إلى فعل، والدافعية ستتحرر، وسيجدون في التعلم لا مجرد وسيلة للامتحانات، بل طريقا لاكتشاف ذواتهم ومكانهم في العالم.
بعد رحلة طويلة عبر صفحات الكتاب، نستطيع أن نفهم بوضوح الرسالة العميقة التي تحملها برجيـت بروت: الجيل الجديد، جيل Z، ليس فاقدا للقدرة أو للذكاء، لكنه يعيش في عالم مزدحم بالسرعة والاستهلاك والانشغال الرقمي، عالم يجعل من الصعب عليه اكتشاف إمكاناته الحقيقية والانغماس في التعلم بعمق.
الكتاب يوضح أن فقدان الحافز ليس مسألة شخصية أو عيبا ذاتيا في الطلاب، بل انعكاس للتفاعلات المعقدة بين الفرد والمجتمع، بين المدرسة والأسرة، بين الثقافة الرقمية وواقع الحياة اليومية. أسلوب بروت السردي، الذي يجمع بين التجربة الشخصية والتربوية العميقة، يتيح للقارئ رؤية هذه الأزمة من داخل الفصول الدراسية، من خلال قصص حية لتلاميذ يعانون من الإحباط، الملل، أو فقدان التركيز، لكنهم يمتلكون قدرات هائلة تنتظر من يكتشفها.
إعادة بناء العلاقة مع التعلم
أحد أهم الدروس المستخلصة من الكتاب هو أن العلاقة بين الطالب والمعرفة يجب أن تُعاد صياغتها بالكامل. فالتعلم ليس مجرد عملية تلقينية، بل فعل إنساني مؤسس، يشكل هوية الفرد ويحدد موقعه في العالم. بروت تؤكد أن هذه العلاقة الجديدة تقوم على عناصر أساسية: (الإصغاء للطالب وفهم احتياجاته واهتماماته/ توفير إطار منظم وواضح يسمح بالحرية والمسؤولية/ إيجاد نتائج ملموسة تمنح شعورًا بالإنجاز/ تحفيز التعلم التعاوني لتطوير مهارات التفاعل الاجتماعي/ الاعتراف بالطالب كشخص كامل وناضج يستحق الاحترام).
هذه العناصر ليست وصفة جاهزة بل مشروع تربوي متكامل، يدمج بين البعد النفسي والاجتماعي والتعليمي، ويعيد للطالب شعورا بالقدرة على التعلم واكتشاف ذاته.
الكتاب يبرز أيضا أن الدافعية ليست شيئا ثابتا يولد مع الفرد، بل مهارة يمكن تعلمها وتطويرها. من خلال سرد حالات سبعة طلاب، تُظهر بروت كيف يمكن تحويل الإحباط والخوف والملل إلى حافز داخلي، عبر أدوات عملية مثل: (تحديد نقاط القوة والضعف/ تقسيم التعلم إلى مهام صغيرة قابلة للإنجاز/ دمج اهتمامات الطالب مع المنهج الدراسي/ التعلم التعاوني والمشاركة في القرار/ تعليم الصبر ومواجهة الفشل كجزء من رحلة التعلم).
هذه الأدوات تخلق لدى الطالب شعورا بالتمكين والسيطرة على مسار تعلمه، وتحول العلاقة مع المعرفة من فرض خارجي إلى اكتشاف داخلي وفضول شخصي.
أعمق رسالة في الكتاب هي فكرة الثورة التربوية الهادئة. بروت لا تدعو إلى تغيير جذري مفاجئ، بل إلى إعادة تأسيس التربية بأسلوب متدرج وعميق يقوم على الثقة والاعتراف والشراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع. هذه البيداغوجيا الجديدة تتيح لجيل Z أن يتحرر من قيود ثقافة السرعة والاستهلاك، ويصبح التعلم رحلة اكتشاف للذات، وليست مجرد وسيلة للنجاح الدراسي أو الحصول على شهادات.
الصرخة الكبرى لجيل Z
في قلب الكتاب، تكمن صرخة صامتة يطلقها كل طالب وشاب: 'أنا موجود، أنقذوني!'. هذه الصرخة ليست مجرد طلب للمساعدة، بل دعوة للراشدين – من الآباء والمعلمين والمجتمع بأسره – للاعتراف بوجود الشباب، وإعطائهم أفقا ومعنى، وتمكينهم من اكتشاف قدراتهم. إعادة إشعال الرغبة في التعلم ليست مهمة فردية، بل مشروع حضاري، يلامس كل جوانب المجتمع، ويؤكد أن مستقبل الإنسانية مرتبط بكيفية تعاملنا مع جيل جديد مليء بالطاقة والقدرات، لكنه يحتاج إلى التوجيه والدعم الصحيحين.
'Génération Z – Libérer le désir d’apprendre' ليس مجرد كتاب عن التعليم، بل دعوة لإعادة تأسيس العلاقة بين الأجيال، ورؤية الشباب ليس باعتباره مستقبلا يحتاج للسيطرة، بل حاضرا يجب دعمه وتمكينه. جيل Z يمتلك الذكاء والإبداع والطاقة، لكن الإطار الصحيح والاعتراف والدعم الاجتماعي والتربوي هي التي تحول هذه الإمكانات إلى فعل ملموس، وإلى رغبة حقيقية في التعلم والمعرفة.
في النهاية، يتركنا الكتاب مع فكرة قوية: التعلم رحلة حياة، والدافعية مهارة يمكن تعليمها، وجيل Z موجود هنا ليترك بصمته في العالم، إذا منحه الكبار الأفق والدعم لاكتشاف ذاته.