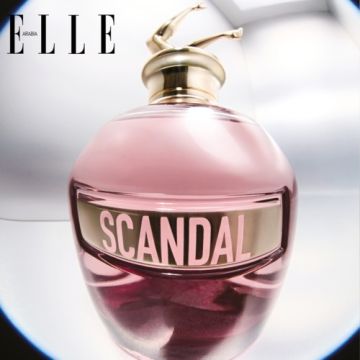اخبار السودان
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
استمرار الحرب يولد مجتمعاً أكثر تجزئة تصبح الولاءات الإثنية المحدد الرئيس للانتماء والتفاعل
شكلت الحرب في دارفور منذ 2003 علامة سوداء في تاريخ السودان، وأثرت بصورة مستدامة في العلاقات الإثنية والقبلية عبر الأجيال. ثم أتت مجازر الفاشر ضمن الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023، لتترك بصماتها العميقة على النسيج الاجتماعي للمدينة والمناطق المحيطة بها، ففي قلب الفاشر تتقاطع جذور الصراع الإثني مع صعود العنف المنظم، مما يعكس هشاشة بنية الدولة ذاتها، وانسحابها على المقدرة على إدارة النزاع، أدى هذا الفراغ إلى بروز جماعات محلية، نشأت في كثير من الأحيان بدوافع حماية المجتمع، لكنها حملت معها إرثاً من الانتقام والعنف الممنهج، مما أعاد إنتاج دورة الفقد والمعاناة التي ضربت أواصر المجتمعات النازحة واللاجئة.
فقد كثير من الأسر في مدينة الفاشر أعداداً كبيرة من أبنائها، ووجدت نفسها أمام صدمة مركبة، الفقد بأشكاله كافة للأقارب والممتلكات والسكن، إضافة إلى انكسار الثقة بين المجتمعات، وقد أدى هذا إلى إعادة تشكيل العلاقات القبلية، إذ أصبح الانتماء الاجتماعي والمكانة في الجماعة مصدر قلق مستمر، ومحفزاً على بناء تحالفات دفاعية جديدة، وتكريس ثقافة الحذر والشك المتبادل. ولا يتوقع أن تقتصر هذه الآثار في الحاضر فقط، بل ربما تمتد لتؤثر في الأجيال القادمة، فالأطفال الذين نشأوا في ظل العنف يتلقون دروساً ضمنية حول الخوف والعداء، وتتشكل لدى بعضهم دوافع الانتقام المكبوتة التي قد تتجسد في مستقبل الصراع المحلي.
إلى جانب ذلك، أثر النزاع في البنية التحتية والخدمات الأساسية، الصحة والتعليم والاقتصاد، مما قد يترك آثاراً طويلة الأمد في المجتمع، ومدى قدرته على الحصول على جزء ولو يسير من هذه الخدمات داخل معسكرات النزوح واللجوء التي أصبحت هي المستقر، كما أن انهيار الاستقرار أضاف بعداً جديداً لعدم الأمان، إذ أصبح السكان أكثر هشاشة أمام الانزلاق نحو الاستبداد أو تجدد النزاع، أو حدوث فوضى اجتماعية داخل هذه المقار.
وهنا تتضح أهمية فهم الصراع في الفاشر ليس فقط كحدث عسكري، بل كعملية اجتماعية تمتد تأثيراتها عبر الزمان والمكان، تحدد شكل العلاقات الإثنية والقبلية، وتشكل القدرة المجتمعية على الصمود أمام الهزات القادمة. وفي وقت تمثل فيه مجازر الفاشر سجلاً من الفظائع، ففي وجهها الآخر ربما تكون أيضاً مرآة لعواقب الصراع طويلة الأمد، وتجسيد لكيفية تشابك الهويات الإثنية والسياسية والاجتماعية في تشكيل مستقبل دارفور.
قال الناشط عبدالسلام يحيى 'جذور محاولات نظام الرئيس السابق عمر البشير لتغيير النسيج الاجتماعي في السودان تمتد إلى استراتيجيات ممنهجة بدأها منذ حرب الجنوب، ولكنها كانت أكثر وضوحاً مع بداية الصراع في دارفور'، ويرى يحيى أن البشير، منذ انقلابه، عمل على ترسيخ مشروع إثني يضع القبائل التي يعتبرها 'عربية' في موقع مهيمن، على حساب الجماعات الأفريقية مثل الفور والزغاوة والمساليت.
وأضاف يحيى 'لم يكن التهميش للقبائل ذات الأصول الأفريقية مجرد سياسة عابرة، بل حجر زاوية في بناء النظام. فبعد سنوات من الحرب، استخدم النظام قانون الجنسية، محاولاً منح امتيازات لمن يراه عنصراً عربياً، وقد خلف توزيع الجنسية والتجنس أثراً متراكماً، إذ أنشأ النظام آنذاك، سجلاً وطنياً مدوناً لمن أتوا من الحرب في سوريا وفلسطين، ليندمجوا فيما عرف بـ’مثلث حمدي‘، وكذلك من دول غرب أفريقيا، لا سيما من عرب الصحراء لدمجهم في دارفور لتعزيز ما وصفه بـ’العنصر العربي‘'.
وأورد الناشط 'تلك المناورة، لم تكن صدفة، بل تعكس طموحاً استبدادياً، فالتلاعب بقوانين الجنسية لمنح الثقل والتمثيل لعنصر مجتمعي معين، على حساب البقية، هو سمة من سمات النظام الذي لا يقبل بالمواطنة المتساوية، بل يرى التمايز الإثني كمصدر للقوة'.
وأضاف المتحدث 'هذا المنهج الإقصائي لم يكن محصوراً في القوانين فحسب، بل تجاوز ذلك إلى عنف الخطاب. فقد ذكر عراب النظام حسن الترابي، في شهاد موثقة بعد المفاصلة في 1999 على إثر خلافه مع البشير، أن الأخير كان قد وصف اغتصاب قواته لنساء دارفور بأنه ’شرف لهن‘، في تصريح صادم يعكس ترفعاً مارسه النظام السابق على ضحايا دارفور'.
وتابع الناشط قوله 'الاغتصاب والاحتفاء به كمنجز، ظهر في تلك الفترة، كما أنه جزء استراتيجي من الحرب الحالية، وليس مجرد نتيجة له، فهو تكتيك لإذلال الجماعات الإثنية غير المرغوب فيها، لزرع الخوف ولإخضاع النسيج الاجتماعي لهيمنة سلطة معينة، وهو ما يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب التي رافقت سنوات حكم البشير'.
ويشير يحيى إلى أن 'انتهاكات الحرب بسبب الرغبة في إعادة هندسة هوية دارفور لم تكن حرباً عابرة على أرض أو سلطة فقط، بل مشروعاً إثنياً عميق الجذور، باستخدم القانون والعنف والخطاب كأدوات لإخضاع الآخر وإعادة رسم النسيج الاجتماعي'.
قال الباحث الاقتصادي معتصم طه 'إن كلفة الحرب الأخيرة على السودانيين تعد عبئاً اقتصادياً واجتماعياً هائلاً، يضرب جوهر الإنتاج الاقتصادي بصوره الزراعية أو الأنشطة التقليدية الريفية، ويقلص آفاق النمو على المدى القريب والبعيد، فالعنف المسلح وتداعياته أوجدا ’حلقة مدمرة‘ من النزوح وفقدان رأس المال، سواء المادي أو الإنساني، مما نكس الاقتصاد المحلي وأسكت صوت النشاط الاقتصادي في دارفور'.
ويرى طه 'على المستوى القريب، يؤدي العنف والتهديدات الأمنية في محيط الفاشر إلى تعطيل العمل الزراعي، فالمزارعون يواجهون صعوبة كبيرة في أية محاولات لاستعادة نشاطهم، إذ يعيش كثير منهم في حالة نزوح مستمر'، وأشار إلى أن قطع طرق التجارة إلى الفاشر وغيرها من مدن دارفور قد تسبب في ندرة سلع أساسية وارتفاع أسعارها، مما يخلق ضغطاً كبيراً على الأسر الريفية التي تعتمد على المحاصيل كركيزة معيشية.
ويواصل الباحث الاقتصادي 'إضافة إلى ذلك، هناك تدمير البنية التحتية الزراعية والقنوات المائية والتخزين، ومنظومات الري الشحيحة أصلاً، كلها تعرضت لأضرار كبيرة، ما قلل الرغبة بالتفكير في الاستفادة من مواسم الزراعة، وبحسب البنك الدولي فالتدهور البنيوي لا يؤثر فقط في المحاصيل الحالية، بل يضعف الأساس الاقتصادي الذي يقوم عليه الإنتاج الزراعي في دارفور، وخصوصاً في الفاشر'.
ويتابع طه 'على مدى أبعد، فإن هذه الخسائر المادية تتجاوز إضعاف المحاصيل موقتاً، إذ إن الصراع يقتل رأس المال الاجتماعي، وهو ما يخلق ضرراً متراكماً، فالأسر التي فقدت ماشيتها أو زرعها وممتلكاتها، لن يكون لديها سوى اللجوء إلى الاعتماد على الإعانات'.
وأوضح طه أن 'هذا الخلل الاقتصادي، إضافة إلى عنصر عدم الاستقرار نسبة إلى وجود السكان في معسكرات النزوح، سيدفع الشباب إلى نزوح مزدوج نحو مدن ومناطق أخرى آمنة، ولكنهم سيقبعون في دائرة العطالة والفقر المخيم على أجزاء واسعة بسبب استمرار الحرب وتعطل وسائل الإنتاج'.
وأفاد الباحث الاقتصادي بأن 'التداعيات الاقتصادية للحرب في الفاشر لا تقتصر على خسائر مادية آنية، بل تنطوي على تآكل طويل الأجل في القدرة الإنتاجية للمجتمع، مما يجعل تحقيق التعافي والتنمية السليمة في دارفور مهمة عسيرة تتطلب تخطيطاً عاجلاً وشاملاً، بمساعدة المجتمع الدولي ومنظماته'.
قالت المتخصصة في الصحة والتغذية رفيعة عباس 'مجازر الفاشر والصراع الدائر في دارفور منذ سنوات لم توقع المجتمع في أذى الجراح الجسدية فحسب، بل خلفت تأثيراً صحياً واسع النطاق يهدد النسيج الديموغرافي والصحي للسكان، لا سيما بين الإثنيات المستهدفة في المدينة'، مشيرة إلى أنه 'وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن انهيار النظام الصحي في الفاشر فاق التوقعات، وقد أوردت أن هناك أكثر من 200 منشأة صحية غير عاملة في الفاشر وحدها بسبب الصراع المستمر'.
وأضافت المتخصصة في الصحة والتغذية 'أن خلو معسكرات النزوح من وسائل الصحة، يضرب قدرة النازحين على تلقي الرعاية الأساسية، ويجعل من الأمراض المزمنة والفجائية تهديداً لهم'، وأن 'منظمة الصحة العالمية سجلت هجمات متكررة على مرافق للمساعدات، مما حرم مدنيين من الحصول على المساندة التي يحتاجون إليها'.
وأشارت المتخصصة في الصحة والتغذية إلى تفاقم سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل في الفاشر ومحيطها، فوفقاً لتقارير 'يونيسيف'، تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد في بعض مناطق الفاشر حدود الطوارئ، وزادت حالات الهزال بين أوساط النازحين. هذا الفقر الغذائي المرتبط بالحصار والتهجير وقطع المساعدات أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، كثيرون منهم لقوا حتفهم بسبب المجاعة وسوء التغذية.
أما عن الأوبئة، فأوضحت عباس أن 'تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض المعدية كفيروسات الماء، فاقمت من الواقع الصحي القاسي مما زاد من ارتفاع الوفيات، لا سيما بين الفئات الأضعف مثل الأطفال والحوامل وكبار السن، مما من شأنه أن يسهم في تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة. ففي موازاة القتل المباشر، وضحايا العنف الجسدي، تزيد الوفيات المرتبطة بالمرض من عدد الضحايا'.
وتؤكد عباس أن 'هذه الأزمات الصحية لا تؤثر بالتساوي في جميع الجماعات الإثنية، فالجماعات التي طردت أو نزحت تفتقر غالباً إلى الوصول إلى أي نوع من الرعاية الصحية، كما أن بعض المخيمات المكتظة تشهد تفشياً أسرع بسبب الكثافة، مما يرسخ التفاوت الإثني في تأثير الأزمة الصحية، كما أن هذه الفروقات الصحية تؤدي إلى إعادة توزيع غير متساو للسكان، إذ يتركز الموت والمرض لدى بعض الإثنيات أكثر من غيرها، مما يغير النسيج الاجتماعي ويزيد هشاشة المجتمع المحلي'.
مع استمرار الحرب، وامتداد مجازر الفاشر إلى ولاية كردفان، واحتمال توسعها، فإن العنف المسلح لم يعد يقتصر على الخسائر المباشرة في الأرواح والبنية التحتية، بل أصبح عاملاً رئيساً في إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي والإثني للمناطق المتضررة، يتوقع أن يؤدي استمرار هذه التحولات إلى ترسيخ الفجوات الإثنية، بحيث تصبح الهوية الجماعية الضيقة معياراً للتفاعل اليومي، بينما تتراجع أشكال الهوية المشتركة التي كانت تجمع المجتمع تحت مظلة أوسع، وأن إعادة تشكيل السلطة المحلية ستكون نتيجة حتمية لهذا الانقسام، مع تراجع دور الزعامات التقليدية، وظهور قيادات جديدة تتشكل وفق الولاءات الإثنية والمناطقية.
من المرجح أن يولد استمرار الحرب والمجازر مجتمعاً أكثر تجزئة، إذ تصبح الولاءات الإثنية والمحلية المحدد الرئيس للانتماء والتفاعل الاجتماعي، وتضعف إمكانات بناء الثقة بين الجماعات المختلفة، كما أن المجتمعات التي تتعرض لصدمات متكررة من النزاع المسلح ستواجه صعوبة في التعافي الاجتماعي الكامل، وسيظل الانقسام الإثني عائقاً أمام أية محاولة لتقوية النسيج الاجتماعي والمصالحة بين المجموعات، علاوة على ذلك تخلق هذه الاختلالات فرصاً لتفاقم التوترات بين الجماعات الإثنية على المدى الطويل.
هذه التحولات الاجتماعية والإثنية ليست مجرد آثار قصيرة الأمد، بل ستترك إرثاً طويل المدى من الانقسام وعدم الاستقرار، يطاول العلاقات الأسرية والقبلية ويؤثر في الهوية الثقافية للأجيال القادمة، مما يجعل إعادة بناء الفاشر ودارفور بعد الحرب عملية أكثر تعقيداً وأشد حساسية على المستويين الاجتماعي والإثني.