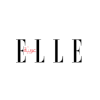لايف ستايل
موقع كل يوم -مجلة لها
نشر بتاريخ: ٢٥ أيار ٢٠٢٥
منيرة الصلح فنانة لبنانية لا تقتصر رؤيتها على الألوان والخطوط فحسب، بل تشمل موادّ وأبعاداً متعددة، تُعبّر عن رؤى فنية تتراوح بين السخرية العميقة والتأمل الذاتي، وتتناول قضايا الذاكرة والفقد والنزوح في عالمٍ متشابك بين بيروت وأمستردام. بتنوع وسائلها بين الرسم، الفيديو، التطريز والنحت، تتخطّى منيرة الصلح حدود الوسائط الفنية التقليدية، مُستندةً إلى تجربتها الشخصية ورؤيتها الثقافية التي تجمع بين الماضي والحاضر. في هذا الحوار، تروي لنا منيرة مسيرتها الفنية وكيف أن العمل الفني بالنسبة إليها ليس مجرد وسيلة للتعبير، بل طريقة للحياة والتفاعل مع مجتمعات مختلفة، وتحقيق التغيير الاجتماعي.
- أعمالك تشمل وسائط فنية مختلفة، مثل الفيديوهات والرسم والتطريز. كيف تختارين الوسيط المناسب لعمل فني معين؟
لا أحدّد مسبقاً المادة التي سأعمل بها، بل أستكشف وأحلّل وأجرّب مواد مختلفة، حيث أتعامل مع الوسائط الفنية ككيانات قد تبدو منفصلة أحياناً، لكنها غالباً ما تكون مترابطة. أمارس الرسم يومياً، لكنني أخوض أيضاً في تجارب إبداعية تمتد إلى المَشاهد البصرية والصوتية، وأعمل في النحت بمواد متنوعة. العمل الفني يقودني بطبيعته، ويدفعني لاختيار الوسيط المناسب له.
لقد تعلّمنا أن المواد والأشياء منفصلة، لكن هذا مجرد تصوّر ذهني؛ في الواقع، كل شيء متصل. على سبيل المثال، عندما تعمّق اهتمامي بالتاريخ القديم، وخصوصاً بأسطورة أوروبا، وجدت نفسي منجذبةً إلى الطين كوسيط تعبيري. بدأت أتخيّل الشخصيات المرتبطة بالحكاية، بل حتى جيرانها وأبناء حيّها وأفراد مجتمعها، وشكّلتهم بأقنعة طينية. منذ الصغر، نشأنا في بيئة مُشبعة بإرث الحضارات القديمة، حيث كان الفخّار والخزف حاضرَين في ذاكرتنا البصرية.
عندما عدتُ للعمل بالطين والسيراميك، بدأت أتخيّل مشاهد كاملة مصنوعة من منحوتات طينية وجداريات سيراميكية، وأتمنى تنفيذها يوماً ما. رغم أنني درست الطين مع الفنان حسين ماضي وفي الجامعة اللبنانية، لم أشعر حينها بدافع لابتكار أعمالي الخاصة. أما اليوم فأراه متصلاً بمواد متعددة، بعدما كان يُدرَّس في المدرسة كمادة منفصلة، وهو ما بدا لي تقييداً للفكر الإبداعي.
عندما ركّزت على موضوع 'أوروبا'، التي اختُطفت من صور، شعرت بأن النحت ضرورة تعبيرية. استلهمت من الوجوه الفينيقية الزجاجية الصغيرة، ومن الوجوه المنحوتة على التوابيت في بلميرا، وكذلك من الفن الروماني والبيزنطي، بل وحتى الفرعوني، حيث كان الفينيقيون على تواصل وثيق مع الفراعنة. هذا التفاعل الثقافي ساهم في توسّع مراكزهم من جبيل إلى صور وصيدا، المدينتين اللتين لطالما تنافستا تاريخياً.
- السخرية والتأمّل الذاتي محوران أساسيان في نهجك الفني. هلاّ أخبرتنا كيف تتجلّى هذه المواضيع في أعمالك، ولماذا تُعدّ مهمة بالنسبة إليك؟
منذ فترة، كتب أحدهم عن أحد أعمالي، وكان العمل يتضمّن دعابة أو القليل من السخرية. ليس هذا شرطاً أو موضوعاً في أعمالي. ولكن القليل من ذلك يساعدني أحياناً بالعمل على مواضيع ثقيلة.
- يتناول فنّك مواضيع الذاكرة والفقد والنزوح. كيف ترتبط هذه المواضيع بتجاربك الشخصية، خاصةً أنك تعيشين بين بيروت وأمستردام؟
هذه قضايا يواجهها الكثير منّا كلبنانيين وسوريين وغيرهم، وهي تنعكس بطبيعة الحال في أعمالي. فمنذ طفولتي في لبنان، اعتدنا فقدان أعزّ الأصدقاء بسبب الحرب والهجرة. وعندما أنهيت دراستي في الجامعة اللبنانية، كنت في منتصف العشرينيات وأردت توسيع آفاقي، فأُتيحت لي فرصة متابعة دراستي في أمستردام. ومنذ ذلك الحين، أصبحت حياتي موزّعة بين لبنان وهولندا.
مع إدراكي لحالة الهجرة التي أعيشها، بدأ اهتمامي يتركّز أكثر على اللغة العربية، ما دفعني إلى العمل على جذور الكلمات العربية، مستكشفةً معانيها المختلفة لابتكار لوحات قماشية كبيرة تعكس إما تناقضات أو روابط متداخلة بين هذه الكلمات.
- تستخدمين الفن للتعبير عن الهواجس الاجتماعية والمشاكل الحياتية. أخبرينا أكثر عن ذلك؟
بالنسبة إليّ، الفن ليس مجرد وسيلة تعبير، بل هو جزء أساسي من طرق العيش والتأقلم مع الحياة، والحروب، والمآسي، أو على الأقل محاولة لاستيعابها. لقد وُلدت ونشأت في بلد مزّقته الحرب، وتنحدر عائلة والدتي من سوريا، ما جعل الحاجة إلى إيجاد متنفّس أمراً ضرورياً للبقاء، وللتعافي من الجراح المستمرة. فالفن يساعد على مواجهة كل ما يحدث، لأنه بطبيعته فضاء للخلق والتجدّد.
كَوني امرأة نشأت في هذه البيئة، من الواضح أن حقوقنا لطالما كانت هشّة، وأن علينا النضال باستمرار من أجلها. أيضاً، كفنانة، واجهتُ في بداياتي واقعاً لم تكن فيه النساء في المشهد الفني يؤخذن على محمل الجد كما ينبغي، إذ كانت صورة 'الفنان العبقري' حكراً على الرجل، بينما اقتصر دورنا على التثقيف والتمهيد له. ورغم أن الأمور اليوم تحسّنت بشكل ملحوظ، فإننا لا نزال في بداية الطريق. اليوم، أصبح العالم أكثر اهتماماً بسماع أصواتنا والتعرف على أعمالنا، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنحققه. في بعض الأحيان، قد نشهد تراجعاً إذا لم نكن يقظين تجاه قضايا أساسية مثل العدالة الاجتماعية والانفتاح، والتي تبقى ضرورية لضمان تقدّم حقيقي ومستدام.
- تلقّيتِ دراستك في مؤسسات مختلفة في لبنان وأمستردام، مثل الجامعة اللبنانية وأكاديمية 'جيريت ريتفيلد'. كيف ساهم ذلك في تطوّرك الفني؟
نعم، هذا صحيح. درست أيضاً آلة الكونتراباس لبعض الوقت في الكونسرفتوار اللبناني، وكان أستاذي هناك الموسيقار المتميز جاك غريغ. في البداية، لم أكن أرغب في الدراسة على الإطلاق، إذ كنت أؤمن بأن الفنانة لا تحتاج بالضرورة إلى دراسة أكاديمية في كلية الفنون. لكن والدتي كانت قلقة عليّ، وبعد فترة نجحت في إقناعي بالتسجيل في جامعة للفنون. هناك، استمتعت ببعض الدروس، خاصة مع الرسّامة فاطمة الحاج، ورغم أنني كرهت أشياء كثيرة في النظام التعليمي، إلا أنه منحني أساساً وهيكلاً قوياً.
في أمستردام، كان في إمكاني التنقّل بالدرّاجة بين المتاحف وأماكن الفن البديلة، مما أتاح لي فرصة مشاهدة العديد من العروض الفنية. اللوحات التي كنّا نُجبَر أحياناً على نسخها في الجامعة اللبنانية، رأيتها أخيراً أمامي في الواقع. لم تكن الدروس هناك تقنية بقدر ما كانت قائمة على المفهوم. ولأول مرة، سألني أحدهم: 'لماذا ترسمين؟'.
كان عليّ أن أدافع عن عملي الفني، وأن أختار المواد التي أستخدمها بناءً على الفكرة، وليس العكس. قبل وصولي إلى أمستردام، كنتُ قد بدأت التصوير. بعد انتهاء الحرب جزئياً وتحرير الجنوب، كنت أستقلّ الباص من بيروت إلى طرابلس، ثم من طرابلس إلى شارل حلو، ثم الطريق البحري حتى أصل إلى الجنوب، وأصوّر الشاطئ كما يظهر من نافذة الباص المرتفع، وكأنني أقيس بعينيّ المساحات التي لم يكن في إمكاننا الوصول إليها خلال الحرب. كنت أحب مونتاج اللقطات التي أصوّرها، وفي أمستردام تعلّمت إتقان هذا الفن، إلى جانب أشياء أخرى. اليوم، عندما أرسم، أتذكّر دروس الجامعة اللبنانية، مثل صفوف دراسة العظام، والتلوين، ورسم الطبيعة، وأمزجها مع ما تعلمته في هولندا. في كلتا التجربتين، كان التفاعل بين التلاميذ مصدراً مهماً للتعلّم، فقد كنا نكتسب من بعضنا بقدر ما كنا نكتسب من الأساتذة. والأجمل من ذلك، أن معظم هذه العلاقات استمرت، وظلت بيننا مودّة وصداقة.
- عملتِ مع مجموعة متنوعة من الشركاء على مرّ السنين. كيف يؤثر التعاون في عمليتك الإبداعية، وما الذي تبحثين عنه في شركائك؟
أخيراً، عندما بدأت في صنع الخيام الضخمة، استرجعت مشاهد من طفولتي لنساء يطرّزن، وكيف كانت هذه الممارسة تتيح لهنّ الاجتماع والتواصل حول عمل مشترك. كانت النساء يتحدّثن، يساعدن بعضهن البعض، يقدّمن الملاحظات، ويعملن بجدّ على تطريز فساتينهن، مما منحهن شعوراً بالفخر والانتماء.
عندما عملت على أحد مشاريعي الفنية، وهو خيمة مطرّزة مستوحاة من خيمة محمد شاه القاجاري من إيران، أدركت أن عملية التطريز ستكون أكثر غنىً وأهمية عند تنفيذها كمجموعة. لم يكن في إمكاني حياكة الخيمة وحدي، لذا بدأت التعاون مع نساء ماهرات في التطريز، يعملن عادةً في تطريز فساتين الأعراس، ويمتلكن خبرة استثنائية في الحياكة. من خلال هذا التعاون، اكتشفت أنني أتعلّم منهنّ بقدر ما يتعلّمن مني، وكنّ يقدّرن العمل الفني ويفتخرن بالمشاركة فيه. لم يكن الأمر مجرد تنفيذ مشروع فني، بل تحوّل إلى مساحة لتبادل المعرفة والقصص. فمع كل غرزة، كنا نسرد حكاياتنا ونستمع إلى أصوات بعضنا البعض. أصبحت الخيمة أكثر من مجرد قطعة قماش مزخرفة؛ بل تحوّلت إلى ملاذٍ للقصص والتجارب النسائية. وعندما تسنح الفرصة، نقيم داخل الخيمة وحولها عروضاً أدائية، ما يجعلها فضاءً يحتضن الحكايا والأصوات المتعدّدة.
- عرضت أعمالك في متاحف وبيناليهات دولية مرموقة، بما في ذلك بينالي البندقية وبينالي الشارقة، ونلتِ العديد من الجوائز العالمية. كيف أثّر ذلك في مسيرتك الفنية؟
سواء شاركتُ في معارض كبيرة أو صغيرة، فالأمر لا يتعلق بذلك بالنسبة إليّ، بل بالعمل الفني ذاته. كذلك، تم اختياري للعديد من الجوائز التي ذُكرت، وهذا أمر رائع، لكنني لا أؤمن بأن أي جائزة تصنع فناناً. بالطبع، أنا ممتنة لأن الجوائز تعكس تقديراً للعمل الفني، وتتيح فرصاً للعرض والتعلّم في سياقات جديدة، لكن وجودها أو غيابها لن يؤثر في مساري؛ فالفن بالنسبة إليّ ضرورة، مثل التنفّس. وإن قُدّر للبعض أن يقدّروا أعمالي، فأرحّب بذلك بتواضع وامتنان، لأن دعم الفنانين أمر ضروري، لا سيما أن هذا كان شبه مستحيل بالنسبة الى النساء حتى وقت قريب. ما يميز بينالي الشارقة هو حجمه وأهميته على المستوى العالمي، فقد أصبح من أبرز الفعاليات الفنية الدولية، بفضل الجهود المستمرة منذ سنوات. لقد أتاح هذا البينالي للفنانين العرب، ومن مختلف الخلفيات والجنسيات، فرصة المشاركة أو الزيارة كل عامين، وهو ما خلق منصة حيوية للتفاعل الفني.
الشيخة حور القاسمي وفريقها نجحوا في جعل الشارقة مركزاً ديناميكياً للفن، حيث باتت المدينة تحتضن أنشطة تمتد على مدار ستة أشهر تقريباً، مما يمنح الفنانين والجمهور فرصة مستمرة للتفاعل مع الفنون المعاصرة والتجريبية. البينالي ليس معرضاً تجارياً، بل مساحة للحوار الفني والإبداعي. زرت البينالي مرات عدة، وشاركت فيه قبل عامين، حيث أُتيحت لي الفرصة للعمل إلى جانب فنانين متميزين. أما بينالي البندقية فقصّته مختلفة تماماً. لبنان، كدولة صغيرة، لم يكن لديه جناح دائم في هذا الحدث العالمي، لكن بفضل جهود القيّمين على الفن، تم إنشاء جناح لبناني في دورات عدة. قبل أربع سنوات، أطلقت القيّمة على الفن ندى غندور الجناح اللبناني في الأرسنال، وكان ذلك اختياراً موفّقاً، حيث أتاح للبنان مساحة ضمن بيئة فنية ديناميكية محاطة بجناحات دول مثل مالطا والفيليبين وأيرلندا، مما سمح بتفاعل غني بين الأعمال الفنية المختلفة.
أنا شخصياً فضّلت هذا الهيكل التشاركي على أن يكون للبنان جناح منفصل ومعزول، فقد عزّز الحوار بين الأعمال الفنية، وهو ما أراه أمراً جوهرياً. كانت تجربة العمل هناك ملهمة، خاصة مع ندى غندور والمصمّم كريم بكداش، إلى جانب الدعم الفني والتقني الذي وفّره غاليري صفير زملر. كما عملت مع صانعي قوارب من لبنان، مما أتاح تجسيد العمل الفني بروح تعاونية مميزة.
- ما هي نصيحتك للفنانين الشباب الناشئين الراغبين في استخدام أعمالهم كأداة للتغيير المجتمعي؟
كونوا أنفسكم. افعلوا ما تريدونه وما ترَونه مناسباً، حتى لو لم يوافق أحد على ذلك.