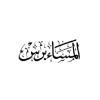اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حين نكتبُ عن بلدٍ حضاريٍ ضَاربٍ بجذوره في أعماقِ التاريخ، كاليمن، أو مصر، فإنّ التاريخَ وحده لا يكفي متنًا وحيدًا نستندُ إليه؛ بل لا بُدّ من العودةِ إلى متونٍ أخرى، لنستطيعَ استنطاق ما أمكنَ استنطاقُه في طريقِ الوصولِ إلى ما تيسّرَ من بعض النتائج والحقائق؛ متونِ الفلسفةِ والاجتماع والجيوبوليتيك والديموغرافيا. الأمرُ يشبه محاولةَ التعرُّفِ على الهرمِ الشّامخ؛ إذ لا يكفي للإحاطةِ به الوقوف أمامَ وجهٍ واحدٍ من وجوهِه فقط؛ بل تستوجبُ المحاولةُ الدورانَ حوله كاملا. وهذه هيَ اليمنُ، وهذه هيَ مصرُ.
باختصار.. هَرَمان تاريخيّان عَتيدان، لفظت القرونُ أنفاسَها على عتباتِ كلٍ منهما..!
في الواقع يصعبُ على كلّ أسفارِ القُرونِ مجتمعة أن تُلمّ بتفاصيلِ هاتين الحضَارتين، أو قل هذين السِّفرين التاريخيين؛ ذلك لأنّ مصر لوحدها 'ليست دولة تاريخيّة، مصر جاءت أولًا، ثم جاء التاريخ' حسب الفيلسوف الروائي نجيب محفوظ؛ أمّا اليمنُ فلم تُكتشف بعدُ، على ما تحتويه من كنوزٍ مطمورةٍ بسوافي الدهرِ وعوادي الزّمن.
العَلاقة بين الحَضارتين قديمة، قِدمَ الحضارتين نفسيهما، وهي علاقةُ أخُوّةٍ ربطت بينهما الجغرافيا المائيّة أولا، كما لو أنهما قصران كبيران، يفصلُ بينهما مَمَرٌ ضيق، هو البحر الأحمر. وبين ثنايا هذا المَمَرِّ الفاصلِ بين الدارين يلتقي أهلُ الدار، ويتبادلان مصالحَهُما اليوميّة. هذا الرابط الجغرافي أفضى إلى روابطَ أخرى: تجاريّة، سياسيّة، دينيّة اجتماعيّة.. إلخ، وذلك عبرَ أزمانِ التاريخِ المتحولةِ. هذه الجغرافيا كانت المسرح المائي الذي مارست عليه مصرُ أكبر وأوسع أنشطتها البحريّة رغم إطلالتها أيضًا على جغرافيّة مائيّة أخرى أكبر، متمثلة في البحر الأبيض المتوسط؛ لكن نشاط مصر في البحر الأحمر أكثر من نشاطها في البحر الأبيض المتوسط. في الأول هي فيه مبادرة وفاعلة وسبّاقة، وصاحبة القرار في أغلب المراحل والتحولات، فيما دورُها في البحرِ المتوسط ثانوي، دفاعي، لا تملك فيه قرارها؛ لهذا حملَ البحرُ الأحمر اسمَ مصر ثلاث مرات: بحر القُلزم كما في المصادرِ التاريخيّة القديمة، وبحر السّويس كما عند ابن خلدون، والبحر الفرعوني كما عند ابن جُبير. وهو ما حاولنا استجلاءه في سُطورِ وصَفحاتِ هذا الكتاب. وهي محاولةٌ متواضعةٌ، كجهدٍ شخصي، إسهامًا في معرفةِ ماضينا، لاستشرافِ مستقبلنا؛ لأنّ من لا يعرفُ ماضيه لا يجيدُ التعاملَ مع حاضره، وهو عن استقراءِ مُستقبله أعجز. نكتبُ عن الماضي، لننطلقَ منه.. لنستلهمَ منه التجارب، ونبنيَ عليه المصَائر.
*******
لقد تشكلت لمصر خلال تاريخها القديم والوسيط هُويّتان بحريتان اثنتان، هُما: هُوية البحر الأبيض المتوسط بما تحمله من قيمٍ غربيّة خالصة، وبما تأبطته معها من تأثيرات غرب أوروبا تحديدًا، المتمثلة في الثالوث الفلسفي الأول، فالهلينية اليونانية لاحقا، انعكس كل هذا في فلسفة التاريخ الوسيط التي تكاد تكون مصريّة خالصَة، بما مثله كلٌ من: بطليموس القلوذي: 100 ــ 170م، وأفلوطين الاسكندراني: 205 ــ 270م، وغيرهما من فلاسفةِ التاريخ الوسيط الذين نبغوا في الإسكندريّة، العاصمة الكوزمبوليتيّة العالميّة الثانية تقريبًا خلالَ تلك الفترة؛ وحتى القديس أوغسطينيوس فقد كان من أبرز المتأثرين بالأفلوطينيّة المحدثة؛ أمّا الهُوُيّة الثانية فهي هُويّة البحر الأحمر، وهيَ هُويّة ساميّة شرقيّة عربيّة، بما تحمله من قيم الشّرق وثقافته.
باختصار.. في مصر التقى 'عقل' الغرب، و 'قلب' الشرق، ومن هذا التلاقي كانت عبقرية الإنسان المصري وفرادته الإبداعيّة في مختلف المجالات. لهذا نلاحظ تميز العقل الجمعي المصري عن غيره؛ فمثلما أنّ ثمّة عقلا واحدًا للفرد الواحد، فإن ثمّة عقلا جمعيًّا للشعوبِ ــ كوحدةٍ جمعيّة ــ تعبّرُ عنها من خلالِ مواقفِها الكبيرةِ والمصيريّة، وفقًا لما يراه الفيلسوف المعاصر جوستاف لوبون. وعبقريّة العقل الجمعي المصري استثنائيّة في كل مراحلها التاريخيّة، ففي كل فترةٍ من فتراتها العصيبةِ تخرج مصر سليمة؛ بل منتصرة وناجحة، على العكسِ من كثيرٍ من الشُّعوبِ التي تغرقُ في معضلاتها الكبيرة، وخاصّة الشُّعوب ذات الطابع الحضاري العريق كالهند والصّين وإيران، وكما هي الحالُ مع دولٍ عريقةٍ في المنطقة كالعراق واليمن؛ لأنّ وقوعَ شعب من الشعوب الكبيرة، ذات الطبيعة المركبة في مشكلاتٍ سياسية أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة كبيرة، يختلف ــ بطبيعةِ الحال ــ عن غيره من الدول الحديثة والطارئة في تعاطيه مع هذه المعضلات، ومع حلها أيضًا.
من وقتٍ مبكرٍ حدست مصر خطرَ الفكرة الشيعيّة عليها أثناء حكم الفاطميين فأهالت عليها التراب، وها هو شعب مصر اليوم يعيشُ حياته الطبيعيّة بسلامٍ، بعيدًا عن خطر هذه الجماعة التي تجاوزها مبكرًا، ولم يسمح لها بالتمدد والانتشار، ومن يقرأ تاريخ مصر القديم والوسيط والحديث والمعاصر يجد أن العصر الفاطمي في مصر قد شهد من الثوراتِ والانتفاضاتِ المجتمعيّة ما لم يشهده تاريخُ مصر كله؛ على الرّغمِ من مدنيّة هذا الشّعب وسلميّتِه؛ لكنهم مع الفاطميين كان لهم شأنٌ آخر، فتعاملوا معهم كغُزاةٍ وجعلوهم أثرًا بعد عين؛ لأنّ المصريين كانوا يرون في التركيبة السّيكولوجيّة للفاطميّة والفاطميين جسدًا غريبًا عليهم، لا ينتمي إليهم ولا ينتمون إليه، وهو ما لم يُتحْ للعراقِ أو اليمنِ اللتين غرقتا في مشاكلهما مع هذه الجماعة منذ قرون، وإلى اليوم يعانيان منها، في الوقت الذي تجاوزت مصر هذه المحنة، بفضل عقلها الجمعي المستشرف للأخطار الكبرى. ورحم الله الرئيس محمد حسني مبارك الذي كان يستخطرُ الشيعة والتشيعَ الإيرانيّ كما يستخطرُ الصّهاينة، ومعه ألف حقٍ في ذلك، وخلالَ فترةِ رئاستِه لمصر مثّلَ حائط صَد تجاه هذه الجماعة التي لم تستطع اختراق المجتمع المصري، ناهيك عن جهازِ الدولة نفسه في عهده.
ذاتُ الشّأنِ أيضًا في نكبة/ نكسة 67م التي هزّت الوجدانَ المصري؛ بل والعربي، وكادت أن تفقده الأملَ بذاته الجمعيّة، والتي عبّر عنها الشاعر المصري عبدالرحمن الأبنودي في قصيدةٍ شعرية، باللهجة العاميّة، كانت على كلّ لسانٍ آنذاك. 'عدّى النهار والمغربية جيّة... ' إلخ، خاصّة بعد أن غنّاها الفنان الكبير عبدالحليم حافظ؛ لكن سرعان ما كانت حربُ العبور بعد خمسِ سنوات البلسمَ الذي أعاد الاعتبارَ للذاتِ الجريحة. ومن يقرأ مذكرات سعدالدين الشاذلي ــ بطل حرب العبور ــ يدرك أهمية الانتصار نفسيًا قبل الانتصار عسكريًا. كما أعقب هذا الانتصار العسكري معركة سياسيّة أخرى، تمثلت في 'كامب ديفيد' 1978م التي أزالت المخلبَ الناشبَ من عنق مصر، فحققت بالسّياسةِ ما لم تحققه بالحرب، وهو ما لم تستطع إنجازه سوريا لا بالسّياسة ولا بالحرب في ذات المُعضلة، فخسرت 'الجُولان' إلى اليوم، في الوقت الذي استعادت فيه مصر أرضَ سيناء بالسّياسة، وهي الخلاصة النهائيّة من كامب ديفيد بالنسبة لمصر.
وذات الشّأن أيضًا مع أحداث 2011م التي تجاوزت مصر تداعياتِها، و 'عبرت المضيق' إذا ما استعرنا هنا مصطلح الدكتور ياسين سعيد نعمان، في الوقت الذي غرقت فيها كلٌ من: اليمن وسوريا وليبيا، ثم السودان مؤخرًا، وقبلهما جميعًا العراق، ولا تزالُ جميعُها بين أتون المعمعة، فيما مصر منتصبة على قدميها بسلام..! إنها العقليّة الجمعيّة المصريّة المتميزة عن كلّ ما عداها من العقليّات الجمعيّة الأخرى، وهي العقليّة التي تكونت من جميع عروقِ التاريخ وكل أمشاجِ الجغرافيا.
وعودة إلى طبيعةِ العَلاقاتِ المائيّة البحريّة ــ إن جاز لنا التعبير ــ بين ضفتي البحرين: المتوسط والأحمر، وفي استقراءٍ تاريخي طويلٍ نكتشفُ أنّ العَلاقة بين ضفتي المتوسط علاقة صراع في أغلب مراحلها، وإن تخللتها علاقات سَلام؛ ذلك لأنّ كلا الضّفتين منشطرتان نفسيًا عن بعضهما. هُوُيّاتيًا: إحدى الضفتين شرقيّة والأخرى غربيّة، ودينيًا: إحداهما مسيحيّة والأخرى إسلاميّة، وجغرافيًا: إحدى الضفتين أوروبيّة والأخرى أفريقيّة/ أسيويّة.. إلخ. ومن ضفة المتوسط الغربيّة كانت غزواتُ الإغريق وحملاتُهم، وكانت الحروبُ الصليبيّة بعد ذلك، وكانت حملاتُ الاستكشافاتِ الجغرافيّة في مرحلةٍ لاحقة، والتي تُعتبر ــ في حقيقتِها ــ حملاتٍ صليبيّةً مخففةً وناعمة، وكانت أيضًا جيوشُ الاستعمار الغربي في العصر الحديث، وجميعُها اجتازت الضّفة الغربيّة للبحر الأبيض المتوسط نحو الضّفة الشرقيّة، وبين حشاها لظىً يتسعّر، وحممٌ تتقاذف.
إنّ 'كرومر' المعاصر في مصر هو في حقيقته ــ فكرًا وسلوكا ــ امتدادٌ للإسكندر الأكبر، ودقلديانوس وأغسطس جاليوس، والمقوقس، وأوروبّان الثاني، وريتشارد قلب الأسد، ونابليون بونابرت.. إلخ. كلُّ خَلَفٍ منهم امتدادٌ لسَلفِه، ولا تزالُ الأطماعُ قائمة إلى اليوم، وتعتبرُ مصر هدفَ هذه الأطماع الأولى، لمكانتها الاستراتيجيّة وموقعها الجغرافي، وتكفي الإشارة إلى أنّ حملتين من الحملاتِ الصليبيّة التسع ــ وهما الخامسة والسّابعة ــ قد خُصصتا لمصر وحدها، دونًا عن بقيّةِ الأقطارِ الشرقيّة التي استهدفتها هذه الحملات، من بينها بيزنطة نفسها، المدينة الكوزومبوليتيّة المشتركة بين الشّرق والغرب التي استهدفتها الحملة الصليبيّة الرابعة، وهي كذلك 'مشتركة' إذا ما نظرنا إليها من منظورٍ جيوبوليتيكي؛ أمّا سياسيًا فهي غربيّة! هذا نموذجٌ واحدٌ فقط من نماذجِ الصّراع التّاريخي بين ضفتي المتوسط، وما أكثرها..!
وعلى العكسِ منها العلاقة الحميميّة والطيبة بين ضِفتي البحر الأحمر عبر التاريخ، وإن تخللتها بعضُ حالات اللاسلم؛ إنما الغالبُ على العَلاقة بين الضّفتين علاقة سلام وَوِئام ومصالح تجاريّة وسياسيّة واجتماعيّة، كما سنوضحُ بين ثنايا السُّطور القادمة؛ ولن نكونَ مبالغين إذا قلنا أنّ ضفة البحر الأحمر الشرقيّة قد عملت على 'أسْيَوة' أفريقيا، في جزءٍ منها، أو هي التي خلقت أفريقيا الأسيويّة.
وعلى الرغمِ من هذا التباين الحدّي بين الهُوُيتين: الشرقيّة والغربيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة، إلا أنّ مصر ــ بعبقريتها الفذة ــ قد استطاعت هضم هذا التباين والقضاء عليه. لقد جعلت منه تنوعًا إيجابيًا خلّاقا، ورافعة من روافع البناء، قبل أن يستغله الخصومُ عاملا من عوامل الصّراع؛ لذا لا طائفيّة في مصر أو جهويّة أو قبائلية أو مذهبيّة. ما هو موجودٌ في مصر: 'مصر' فقط..!
عبر عصور التاريخ المختلفة تدفقت كلُّ الأجناس والأعراق والأمم في هجراتٍ جماعيّة إلى مصر، حيث التقى الآشوريون والبابليون والسّلوقيون والإسرائيليون والفرس والرومان واليونان والأتراك والعرب؛ لكن هذه الأجناس والأعراق انساحت وذابت جميعُها في البيئةِ المصريّة، ومكثت فيها إلى غيرِ رجعة، إذا ما استثنينا الإسرائيليين الذين غادروها، وذلك بفعل تكوينهم النفسي وصرامة تعاليمهم الدينيّة، ومنها فكرة 'أرض الميعاد'. وإلى هذه الحقيقة أشار المؤرخ المقريزي في سياقِ حديثه عن العربِ ــ وهم أكثرُ الأممِ تأثيرًا على مصر ــ بقوله: 'اعلم أنّ العربَ الذين شهدوا فتح مصر قد أبادهم الدهرُ وجُهلت أحوالُ أكثرِ أعقابهم'. كما يقول المفكر المصري المعاصر الدكتور جمال حمدان: 'إذا كان العربُ قد عرَّبوا مصر ثقافيًا، فإنّ مصر قد مصّرتهم جنسيًا'. هذا الامتزاج والتلاقح هو الذي خلق العبقريّة المصريّة بفرادتِها الإبداعيّة المتميزة، وذلك لأنّ الشخصيّة الحضاريّة للأمّة المصريّة كانت قد استقرت منذ زمنٍ سحيق. ويكفي التذكير هنا بشخصيّة إبداعيّة مصريّة حديثة، هي من نتاج هذا التلاقح والامتزاج الاثنولوجي، وهو الشّاعر المصري الكبير أحمد شوقي، كدليلٍ عابرٍ من بين آلافِ الأدلة، فهو ــ كما تذكرُ الأخبار ــ مصري، من أصولٍ كرديّة، أمه يونانيّة، جدته لأبيه شركسيّة، وجدته لأمه يونانية. ومثلُ نموذج شوقي آلاف النماذج.
إنّ روحَ الحضارةِ الأرثوذكسيّة شرقيّة، بدليل تقبلها للحضارةِ الإسلاميّة وخضوعها الكامل لسلطانها بكل يُسر وسَلاسة، وفقًا لإشارةِ المفكر العربي شارل عيساوي، 'الإسكندرية والقسطنطينية/ استانبول' حاليا، أنموذج. خلاف الحضارة الكاثوليكيّة التي تمنّعت ــ حد الاستعصاء ــ حتى في التعايش والقبول بالآخر 'الأندلس أنموذج'. وإنّ هذا لدليلٌ قاطعٌ على أنّ الالتقاء الحاصل هو ــ في حقيقته ــ التقاءُ أمزجةٍ وأرواحٍ أولا، قبل أن يكونَ التقاء أفكارٍ وعقائد ثانيًا. بمعنى أنّ روحَ الشّرق واحدة، كما أنّ روحَ الغربِ واحدةٌ أيضًا. بمعنى أكثرَ وضوحًا: انشطرت المسيحيّة على نفسها ما بين شرقيّة أرثوذكسيّة وغربيّة كاثوليكيّة، حتى وجدت الأولى نفسَها إلى الإسلام أقرب منه إلى نظيرتها 'الكاثوليكيّة'، أو حتى 'البروتستانتيّة' الغربيتين، على ما في الأخيرةِ من مُرونةٍ وانفتاحٍ وتقبلٍ للآخر، وعلى مظلوميّتِها التاريخيّة من نظيرتها 'الكاثوليكيّة'. أضف إلى هذا أيضًا أنّ الكاثوليكيّة الغربيّة المعاصرة قد احتلت بعضَ بلدان حوض المتوسط الشرقيّة، ومنها مصر، ومع ذلك لم تستطع التأثير عليها كثيرًا إلا في الحد الأدنى من أنماطِ المعيشة اليوميّة، وإبّانَ هذا الاحتلال كان الأرثوذكسي المسيحي الشرقي في مصر والشام يجد في المسلم قريبًا له، أقرب من أخيه في العقيدة: الكاثوليكي الغربي..!
إنّ تجربةَ الإسكندريّة مريرةٌ من وقتٍ مبكر، ابتداءً من عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي نكل بأقباط مصر وأزهقَ أرواحهم أواخر القرن الميلادي الثالث، كما فعل مع آخرين، من أجلِ استعادةِ الوحدة الرومانيّة التي بدأت بالانهيار آنذاك، حين كانت روما لا تنظر إلى مصر والشّام إلا كخزانٍ للحبوب والعائدات الماديّة فقط، وكانت الإسكندريّة جزءًا من ولاياتها المترامية الأطراف؛ لكنها استعصت عليه وصمدت أمام طغيانه وجبروته الأرعن، وحافظت على تقاليدها وهُويّتها الشرقيّة الخاصّة، ولتخليد مواقف أبنائها الأبطال من الضّحايا تعمدت الكنيسة القبطيّة تأسيس تقويمها التاريخي ابتداءً مما أسمته 'سنة الشهداء'، 284م، وهي السَّنة التي أُزهقت فيها أرواحُ الأقباطِ المصريين على يد جلاوزة دقلديانوس..!
هذا استطرادٌ قد يبدو بعيدًا عن موضوعنا الأساس؛ لكنه غير مُنبتِّ الصّلة عن الفكرةِ الرئيسيّة التي نحن بصددها، وهي واحديّة الروح الشرقيّة أيا كانت عقيدتُها أو جنسُها أو جغرافيتُها. وهي إشارةٌ أيضًا إلى الهُويّة الثقافيّة للبحار، التي تشبه الهُويّة الثقافيّة للصَّحارى والسُّهوب.
دخلت اللغة العربيّة مصرَ بدخولِ الإسلام، وكان اللغتان: اليونانيّة والقبطيّة هما السّائدتان آنذاك، وما أن انتهى القرنُ الهجري الثالث حتى أصحبت اللغة العربية لغة الشّعب المصري كاملا؛ كما كان الإسلامُ دينَ الشعب كله، عدا قلة من الأقباط الذين بقوا على عقيدتهم المسيحيّة، متصالحين مع المسلمين مِن حولهم، منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم، وبهذا صارت مصر عربيّة خالصَة، مسلمة خالصَة، إلى الأسيويّة العربيّة أقرب منها إلى الأفريقيّة الحاميّة، خلاف فارس/ إيران التي دخلها الإسلام واللغة العربيّة فاستعصت عليهما معًا؛ بل لقد عملت فارس قديمًا على 'فرسَنة' الإسلام بصورةٍ مُشوّهةٍ منه، ثم إعادة تصديرها مرةً ثانية إلى موطنِ الإسلام الأصل، 'بلد المنشأ' عبر وكلاء وجيوب مصطنعةٍ في أنحاء البلاد الإسلاميّة، وبواسطةِ فرقٍ وجماعاتٍ متعددةٍ، من مزدكيّة وشعوبيّة ومانويّة وزرادشتيّة وإيزيديّة، ومؤخرا 'خمينيّة'.. أفكار مشوهة و 'مسرطنة'، نعاني منها إلى اليوم..!
والحقيقة أنه لم يتوقف خطرها على البلاد الإسلاميّة فحسب؛ بل لقد وصل إلى بلاد الهند في مرحلة تاريخيّة ما؛ حيث دخل الإسلام الهند، إبّانَ حكم 'المغول'، من القرنِ الثالث عشر الميلادي، وحتى القرن السّادس عشر الميلادي، ولكن باللسانِ الفارسي 'اللغة'، فكانت النتيجة أن 'تفرسنت' الهند أكثر من أن تُسلِم، لأنّ اللغةَ حين تنتقلُ من أمّةٍ إلى أخرى تنتقلُ ومعها فلسفتها وهُويتها وثقافتها. لقد غلبَ اللسانُ على القلبِ مذ ذلك الوقت وإلى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ والثقافة الفارسيّة منتشرة في الهند، بفعلِ انتشارِ اللغةِ الفارسيّة آنذاك التي استغلت الإسلامَ لتعبُرَ من خلاله، وقد تمّ القضاء على الديانةِ الإسلاميّة هناك؛ لكن الثقافة الفارسيّة باقية إلى اليوم، على الأقل في جزءٍ منها، كما هو الشّأنُ مع اللغةِ اليونانيّة التي نقلت إلى مصر هُويّتها وثقافتها، وكما هو الشّأنُ مع الإنجليزيّة التي نقلت هُويّتها وثقافتها إلى الهند أثناء احتلال بريطانيا لها، فخرجت بريطانيا بجيوشها من الهند؛ لكن ثقافتها باقية إلى اليوم..!
إنّ مصر ليست مجردَ دولةٍ فحسب؛ بل امبراطوريّة، وهي تحملُ كل مقوّمات الدولة الإمبراطوريّة التي يمتد نفوذها إلى خارج جغرافيتها، بناءً على تواجد مصالحها؛ لهذا عادة ما تتمدد خارج حدودها، أو تحاولُ على الأقل بين كل فينةٍ وأخرى، وليس بوسعها الحفاظ على كينونتِها الداخليّة إلا أن تفعلَ ذلك أساسًا. إنها سُلطة الجيوبوليتيك السّياسي التي تفرضُ نفسها بنفسها؛ لأنّ للطبيعةِ حُكمَها وأحكامَها القاهرة التي لا تُرد أو تُستأنف.
ولن نغوصَ كثيرًا في ملاحمِ التاريخ الفرعوني القديم خلالَ عهود الأسرات المتعاقبة، للتدليل على ذلك. تكفي الإشارة إلى الاستراتيجيّة السياسيّة للقائد العظيم صلاح الدين الأيوبي حين عمل على استعادةِ قوة مصر؛ لتنبريَ مدافعة عن الأمّةِ الإسلاميّةِ والعربيّةِ ضد الغزو الصليبي، فكان أول ما فكر به ذلك القائد هو بسط نفوذه الكامل على الشّام شرقا واليمن جنوبًا؛ أمّا بلادُ الشام فلاتصَالها بالعراقِ وهضبة الأناضول شمالا، خط الدفاع الأول؛ وأمّا اليمنُ فَلِتحكُّمِها الاستراتيجي بجنوبِ البحر الأحمر ومضيقِ باب المندب، واستشرافها للمحيط الهندي. ومواجهتها أيضًا للحبشةِ المسيحيّةِ آنذاك التي من الممكنِ أن تستعيدَ حِلفها التاريخي مع إخوتها في العقيدة، كما حصلَ أيّام الإمبراطور البيزنطي 'جستنيان' وصراعه مع الفُرس على خطّ الحرير الصّيني الذي كانت تتحكمُ اليمنُ بمَمَرِّه البحري، بعد أن قطعت فارس خطَّه البري في أراضيها، فكان أن غزت الحبشةُ أرضَ اليمنِ بأساطيل بيزنطة، متذرعة بمحرقةِ الأخدود في 'نجران' أيّام الملك الحميري يوسف أسأر 'ذو نواس' الذي خذلته القبائلُ اليمنيّة في معركته هذه، لعلاقته السّيئة بهم آنذاك، ومن ثم السّيطرة على المدنِ اليمنيّة قرابة خمسين عامًا. هذا أولا، وثانيا: فالأطماعُ الأوروبيّة على أوجها في بلاد الشّرق، وقد يُمثّلُ بابُ المندب والبحر الأحمر مدخلًا خطيرًا لها، كما حصل سابقًا إبانَ الصّراع الآشوري المصري، وكما حصل لاحقا إبّانَ الحملاتِ البرتغاليّة فالأوروبيّة بشكل عام مطلع القرن السادس عشر فما بعده، وبالتالي فلا بدّ من تأمينِ هذين الاتجاهين: الشام واليمن. وهو ما كان فعلا، ولا تزالُ كثيرٌ من القلاعِ والحُصونِ في اليمنِ شامخة إلى اليوم منذ العصرِ الأيوبي، كما سنوضح ذلك في الحديثِ عن الدولةِ الأيوبيّةِ في اليمن. هذا نموذجٌ من التاريخ القديم والوسيط.
وفي التاريخ الحديث والمعاصر ــ وخاصّة خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ــ كانت بريطانيا ترى في نفسها وصيّة على العالم كله، شرقه وغربه، فسيطرت على البحارِ والمحيطات، كما احتلت كثيرًا من البلدان، من ماليزيا في شرق آسيا، إلى الهند في الشّرق الأقصى، إلى مصر وجنوب اليمن ومشيخات الخليج العربي في الشّرق الأوسط، وإلى جانب بريطانيا أيضًا 'صديقتها اللدود' فرنسا في الشّام والمغرب العربي، في صورةٍ صليبيّةٍ جديدة، بجيوشٍ نظاميّة، خلاف الحروب الصليبيّة التي كانت حربَ شعوبٍ لشعوبٍ، بصورة مباشرة، فانبرى لهما القائد العربي الجديد الزعيم جمال عبدالناصر الذي أمّمَ قناة السّويس أولا في العام 1956م، وخاضَ حربًا شرسة ضد ما عُرف بالعدوان الثلاثي آنذاك: 'إسرائيل، فرنسا، بريطانيا' كما عمل على طرد بريطانيا من جنوبِ اليمنِ المحتل، بعد أن كبّدها خسائرَ فادحة منذ منتصف الخمسينيّات وحتى العام 1967م، ثم ما أعقب ذلك من انسحابها من بقيّة بُلدان الخليج العربي، وتحديدا: الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعُمان التي استقلت جميعُها خلال العامين: 70 و 71م من القرن الماضي. ويأتي هذا النصرُ بعد تكريس مصر عبدالناصر لجزءٍ من جهودها، من أجل مواجهة بريطانيا في المنطقة العربيّة، وبعد تأسيسِ، أو محاولة تأسيس 'دول الاتحاد العربي' في العام 1958م، بين كل من: الجمهوريّة العربيّة المتحدة 'مصر وسوريا' من جهة، والمملكة المتوكليّة اليمنيّة من جهةٍ أخرى، والتي لم يصمد اتحادها كثيرًا، لأسبابٍ عدة، ليس هنا مجال تفصيلها، فقط أردنا الإشارة إلى ذاتِ الاستراتيجيّة المصريّة في كل أنساقها التاريخيّة لدى زعماءِ مصر الكبار، وهي الاهتمام الكبير بكلٍ مِن: اليمن أولا، فالشّام ثانيا؛ علمًا أنّ هذه الاستراتيجيّة كانت من ضمنِ أولويّات محمد علي باشا، نظريًا، إلا أنه أخفقَ عمليًا في تنفيذها؛ لأنه اضطُر ــ آنذاك ــ لأن يحاربَ على أكثر من جبهةٍ في وقتٍ واحدٍ معًا، فأوقفت حروبُه تلك تنفيذ استراتيجيّته تجاه اليمن، ولهذا تقفُ مصر اليوم بقيادةِ الرئيس عبدالفتاح السّيسي مع اليمن من ذاتِ الاستراتيجيّة ونفسِ المُنطلق، وهي العَلاقة البحريّة اليمنيّة المصريّة التي لها تأثيرٌ مباشرٌ على مصر.
هذا عن الهَرم، فما ذا عن السّد؟!
نقول: إذا كان من حق أرضِ الهَرم أن تفخرَ بما تمّ استكشافه فيها في القرون الثلاثة الأخيرة على صعيدِ التراث المادي، وبما قدمته للأمّة العربيّة أيضا؛ فإن لأرضِ السّد أن تفخرَ بما لا يزالُ قيدَ بطونها ولم يُكتشف بعد، عدا النزر اليسير، واليسير جدًا..! وإذا كنا قد عرفنا وجه مصر المشرق والبهي، فإنّ وجه اليمنِ لا يزالُ غائبًا مغيبًا حتى اللحظة، وإذا كانت مصر قد حظيت بأبناء وأحفاد بارين بها، فإن اليمن ــ ويا للأسف ــ قد مُنيت بأبناء أشقياء، كشقاء 'قدّار'، عاقر الناقة، عدا القليل منهم؛ إنما رهانها اليوم على الأحفاد. ويكفي الأبناء شقاءً تقصيرهم في حق ثورةِ السّادس والعشرين من سبتمبر المعظم 1962م التي باعوها بثمنٍ بخس، كما لو أنهم 'أبو غبشان الخزاعي' الذي باع أعزّ ما يملك بأحقر ما استلذ؛ إذ باع مفتاح الكعبة بزقّ خمر، وفيه قال الشاعر:
باعتْ خزاعةُ بيتَ الله إذ ْسكِرت
بزقِّ خمرٍ فبِئستْ صفْقةُ البادي
باعتْ سدانتها بالنَّزْر وانصرفت
عن المقام وظلَّ البيتُ والنادي
وبحسب الأستاذ خالد الرويشان: 'لم يكن قيام الجمهوريّة في اليمنِ سَهلا. كانت أغلى جمهوريّة في التاريخ، وكانت الأكثر كُلْفة وتضحية.. كانت الأغلى. وسلّمها أرخصُ الرجالِ للإمامةِ بعد خمسين عامًا'.!
على أيةِ حال.. من يقف على جزئيّةٍ محددة من تاريخِ اليمن فقط، وهي جزئية الفنون التي تم اكتشافها حتى الآن يستطع الوقوف على حقيقةِ واحدةٍ من الحضَاراتِ الإنسانيّة العريقةِ التي أذهلت مَن عرفها حتى الآن، ومَن عرفها قليل.. الحضَارة اليمنيّة القديمة..
إنّ معرفة الفنِّ لأيّ مجتمعٍ من المجتمعاتِ معناه النفاذ إلى عُمقِ هذا المجتمع والغوص في وعيه الباطن، معناه الحفر عميقًا في منجم الذات الجمعيّة التي صنعت مادة هذا الفن، والتي تستدعي أسئلة بعيدة الغور، عميقة الغوص، من قبيل: ما النّبعُ الذي تدفقت منه هذه الفنون؟ وما المسَارب التي تمشت فيها؟ وإلى أي مصبٍ انهمرت وغاضت؟ ماذا يعني الفنُّ لأمّة اليمن القديمة؟!
الفنونُ صنعة رفاهيّة بطبيعتها، ولا يمكن لأيّ مجتمعٍ من المجتمعاتِ أن يتجه نحو الفنون، في مراحله التكوينيّةِ الأولى، إلا بعد أن ينتهي من الأساسيّات والضّروريّات، وذلك باعتبارِ الفنّ من الكماليّات والتحسينيّات، وإن كان الفنُّ لزيمَ الإنسانِ وجودًا وعدمًا، وفي كل حالاته.
ومنظومةُ الفنون العامّة ــ من موسيقى وشعر ورسم وبناء ونحت ورقص وغناء وتمثيل ــ حالةٌ روحيّة قبل أن تكونَ ماديّة، تستلهمُها الأمّة من خصائصِها الجمعيّة، ومن طبيعتها الجغرافيّة وموروثاتها التاريخيّة، مُضفيةً عليها مزاجها الإنساني الخاص الذي تطبّعت عليه، بفعل التراكم التاريخي الهُويّاتي، باعتبار الفنون هي الصّلة بين الإنسان والطبيعة، بين الحقيقة والخيال، وفقا للفيلسوف والكاتب سلامة موسى. وعادة ما تمثلُ فنونُ الملاحمِ التاريخيّة لأيّ أمّةٍ من الأمم روحها الجمعيّة ومزاجها الكلي، تجسيدًا للطاقة الخلاقة والمبدعة في ذهنيّة الشُّعوب وذاكرتها.
الفنون ــ من ثَم ــ هي البراهينُ الصّادقة على وجودِ الأمّة حين يغيبُ كل الشهود، ونقصد بالوجود هنا: الوجود الواعي، الوجود الحضاري الفاعل الذي يُحيلُ على البناء عليه والانطلاق منه، لا مجرد التواجد الصّنمي في صورته السّلبيّة. ووفقا للبردوني: 'أعلى قيم الفن تكمنُ في اكتشافاته الإنسانيّة؛ لأنه يشيرُ إلى ما يعتمل في نفسِ المجتمع من شوق، وما يعتلج فيها من هموم. فعن طريق الفنون تتجلى الطوايا النفسيّة حتى أصبح الفنُّ القولي أهمَّ من التاريخ، لانبثاقه من الداخل، وإيماءاتِه إلى غير المرئيّ من حياةِ الأجيال'.
الحضارةُ اليمنيّة القديمة جزءٌ من حضارةِ الشرق، ترتبط فيها الفنونُ بالأديان ترابطا وثيقًا، ويكاد يُخيّل للناظر أنّ المعابدَ قاعاتُ فنون، أو أنّ قاعاتِ الفنون محاريبُ دين، وهي متلازمة تاريخيّة لا تنفك عن الروح أساسًا؛ لأنّ المبدعَ يكون سماويًا حين يُبدع، وفقا لأوشو، ومن يُلِم ــ وإن بالحد الأدنى ــ بالفنونِ الأوربيّة يدرك ذلك بوضوح، فأبرزُ وأعظمُ اللوحاتِ الفنيّة الحديثة مستوحاةٌ من الكتاب المقدس، لوحة 'العَشاء الأخير' أنموذج.!
في حضارةِ اليمنِ القديم وُلد الفنُّ في أبهاءِ المعابد، كما هو الشّأنُ في الحضارةِ المصريّة القديمة، في عمليّة تصالحٍ خلّاق؛ وإن شئتَ قل: في عمليّة التحامٍ روحي فني متجانس، تؤكده مقولة هيجل الشهيرة: 'المُنتَجُ الفني لا يوجدُ إلا إذا اتخذ مساره عبر الروح، وفي الإنتاج الفني الجوانب الروحيّة والحسيّة يجبُ أن تكونَ شيئًا واحدًا'. هذا ليس غريبًا في الأساس، فلقد تكاملت الروح الدينيّة مع الفن.. الدين باعتباره حدسًا تذوقيًا قلبيًا قبل أن يكونَ عقليًا. كذلك الفن، باعتباره حالة روحيّة قلبيّة؛ لهذا نجد منظومة الفنون اليمنيّة القديمة من نحتٍ وتصويرٍ ورسمٍ وكتابةٍ ومعمارٍ متناثرةً على قممِ الجبال، وبين بطون الأودية، وفي متون الصّحارى. ونجدها متنوعة، تناولت الإنسان شكلا وموضوعًا، كما تناولت الحيوان؛ بل كما تناولت الطبيعة ذاتها؛ ولأنّ اليمنَ أرضُ التوحيد السّماوي الأول، مُذ نبي الله هود عليه السلام، فمن الطبيعي إذن أن تتصدرَ قائمةَ المسَارح الفنيّة الأولى في التاريخ، وإن كانت هذه الفنونُ لا تزال رهنَ مسارحها الأولى ولم تُكتشف بعد، إلا النزر اليسير والقليل.
باختصار.. إنّ ممارسة اليمني القديم للفن دليلٌ على وعيه بأهميّة الفن؛ إذ لا يمكنُ لمجتمع ما ممارسة الفن بدون معرفة جدوى الفن، ولا شك أنّ هذه المعرفة وليدة قرونٍ طويلةٍ بالتجربةِ المتراكمة، وبالتطور العقلي والارتقاء الفني. وبهذا يكونُ اليمنيُّ القديم قد جمع بين التطور الذوقي من خلال الفن، وبين التطور الطبيعي من خلالِ براعته في الهندسة والبناء والفلك. لقد اسْتَكنَه الأشياء من داخلها فكان فنّانا، ونظرَ إلى العَالم من خارجه فكان عالِمًا.
إنّ الالتحامَ النفسي بين الفنّ والدينِ في مراحلِ التاريخ المبكرةِ أفضى إلى خلقِ بُعدٍ ثالثٍ في هذه العمليّة، وهو الالتحامُ الطبيعي، فتصالح اليمنيُّ الأول معها، مُنتجًا ذلك الإبداع الخلاق الذي نلمسُه في فنونِ المعمار والمدرجات والسُّدود والقنوات والطرق، ولا تزال معالم هذا الالتحام صامدة منذ آلاف السنين. إنه إبداعٌ جمعيٌّ، بمتواليةٍ إبداعيّةٍ من صنعة الأجيال المتعاقبة؛ لأنّ الهياكلَ العظيمة لا تستقلُّ ببنائها دولة واحدة، وفقا للرؤية الخلدونيّة التي ضرب المثل فيها ــ في مقدمته الشهيرة ــ بقرطاجنة وسد مارب، والأمرُ كذلك حقا؛ لأنّ الإبداعَ الجمعيَّ يفضي إلى خلقِ نهضةٍ جامعة، فيما الإبداعُ الفرديُّ يخلف صورًا غير متجانسة، فيحيل عدم التجانس إلى التناقض الذي يُفضي ــ بدوره ــ إلى الصّراعات البينيّة، في عمليّة ارتدادٍ داخليٍّ للذكاء، تتآكلُ معه وبه الذاتُ الجمعيّة، وهو ما نعيشه منذ قرونٍ، على الأقل منذ أفول نجم الدولة الرسوليّة، منتصف القرن التاسعِ الهجري؛ لأنّ ذاتنا الجمعيّة اليمانيّة انحرفت عن هُويّتها التاريخيّة الجامعة، بفعلِ الحروب البينيّة أو الصّراعات الاجتماعية التي مُنيت بها البلاد، وهو على العكسِ من بلدٍ حضاري عريق وأصيلٍ مثل مصر التي لم تنقطع عن حضارتها، ولم تتآكل ذاتُها التاريخيّة أو تضطرب شخصيّتُها الحضاريّة بفعل الاستقرار الدائم. وليس أخطر على أمّةٍ من الأممِ من أن تضطربَ في شخصيتها أو تغتربَ عن ذاتها، والسّببُ واضح، 'الإمامة' السّرطان الأخبث، وإن شئت قل ــ وفي صورةٍ جامعة ــ: غياب القائد الكبير بحجم الجغرافيا، وبحجم التاريخ؛ على الرغمِ من أنّ اليمنَ مكتنزةٌ بالعناصرِ الأصليّة المكونة للحضارة، والمتمثلة في: قوى الأجداد، الخُلق والذكاء، المعتقدات الوجدانيّة ذات الشكل الديني والسياسي، العادات، الأخلاق، التربية، والنظم السياسيّة التي تحدث عنها الفيلسوف جوستاف لوبون باستفاضة. أو ما أسماه توماس هوبز: الفضائل الطبيعيّة والفضائل المكتسبة. هذه العناصرُ ــ في مجموعها ــ متناثرةُ في أرجاءِ اليمنِ الكبير، ولكن لا يجمعُها خيطٌ ناظم، متمثل في 'القائد الأطول والأكبر والأفرع'، بقدر ما يسيطرُ عليها الصّراع والصّراع المضاد في جدليّة تاريخيّة تختلف عن جدليّة 'صراع ماركس الطبقي' الذي نظّرَ له طويلا في فلسفته.
منذ زمنٍ بعيدٍ كانت اليمنُ الخزّانَ البشري الذي فاضَ بعشراتِ الهِجراتِ الجماعيّة إلى كل من: مصر والعراق والشّام وشمال الجزيرة العربيّة وشرق أفريقيا والأندلس، ولا تزالُ موجاتُ الهجرةِ والنزوح قائمة إلى اليوم، وإن بطريقةٍ مختلفةٍ وأقل مما كانت عليه سابقا، لأكثر من سبب، أهمها سرطان الإمامة الذي جعل من اليمنيّ غريبًا في وطنه، غريبًا شريدًا خارج وطنه. ابتلعته البحار والمحيطات، وغوّرته السُّهوبُ والأودية في مُختلف القارات، وفي قصائد: 'غريبان وكانا هما البلد' أو 'مسافر بلا مهمّة' للبردوني، و 'البالة' لمطهر الإرياني، و 'غريب على الطريق' لمحمد أنعم غالب ملاحم إنسانيّة تاريخيّة تحكي مأساة اليمني المشرد البئيس في مختلف الأصقاع عبر الأزمان.
رحلَ النَّبعُ من جذوري فهيّا
يا هشيمَ الغُصونِ نَتْبَع خريرَه
وإلى أينَ يا منافي أخيرًا؟
وتشظّتْ في كُلِّ مَنفىً أجيرَةْ
هكذا ما جرى لأنَّ بلادي
ثروةُ الآخرينَ وهي الفقيرَة.
د. ثابت الأحمدي
القاهرة نوفمبر 2023م.